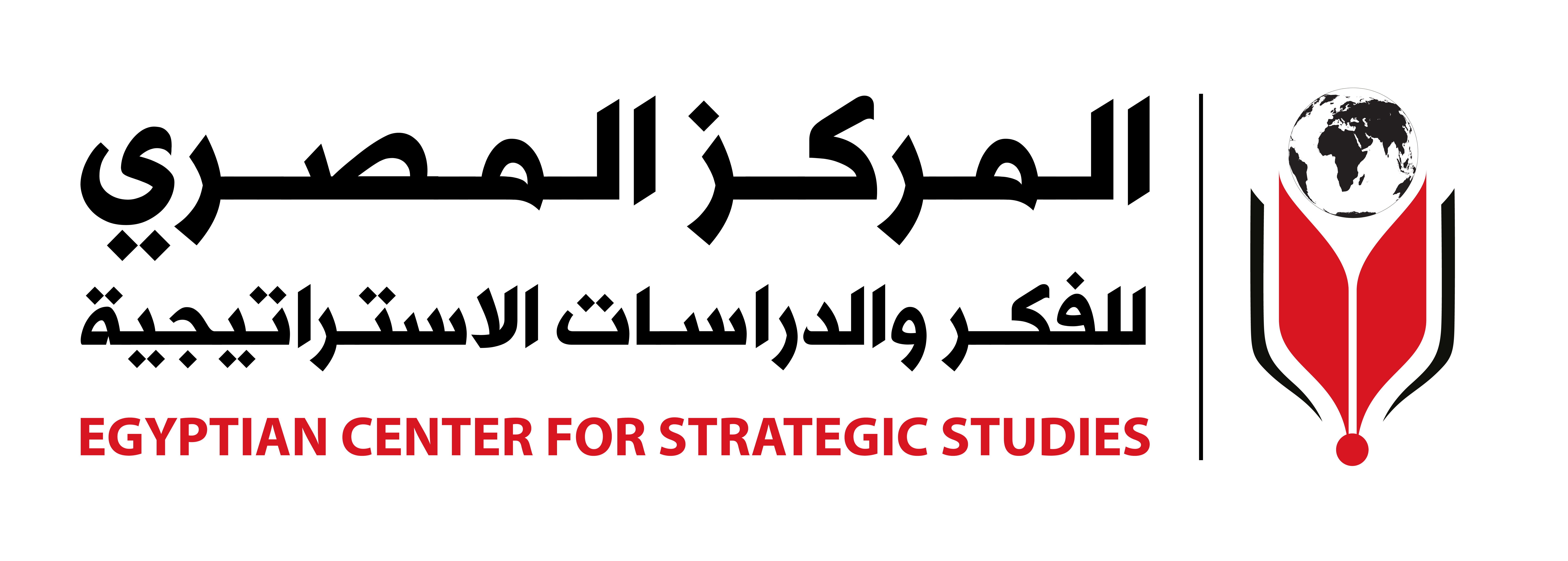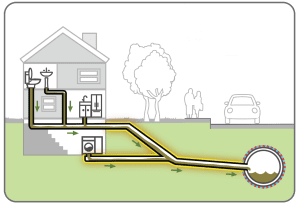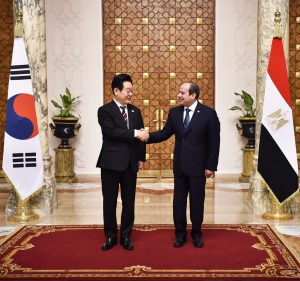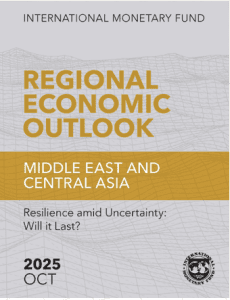لو أن هناك شيئا واحدا يميز مصر عبر العصور فهو الدولة المركزية. كانت مصر فرعونية وبطلمية ورومانية وعربية وإخشيدية وفاطمية وأيوبية ومملوكية وعثمانية، وفى كل هذه العصور كانت هناك دولة مركزية واحدة، تحكم الوادى والدلتا، وتنشر الكشافة والبصاصين فى الصحارى المحيطة لترصد حركة الغزاة.
قيام الدولة المركزية هو نقطة البداية لأعجوبة الحضارة المصرية. نزل المصريون إلى الوادى قبل ستة آلاف عام، فأسسوا مستوطنات زراعية متفرقة، حكمها ملوك محليون، عرفنا أسماء بعضهم. توحدت الممالك المصرية فى دولتى الشمال والجنوب، وقبل مرور ثلاثة آلاف عام على وصول المصريين إلى الوادى كان الملك نارمر مينا يوحد الدولتين، ليؤسس أقدم حكومة مركزية فى التاريخ.
مدهشة تلك السهولة والسرعة التى توحد بها المصريون، ومدهش استعدادهم، للعيش معا تحت حكومة مركزية واحدة، ومدهش نفورهم من الانشقاق والتمرد، فبقدر ما أحب المصريون العدل والحاكم العادل، بقدر ما كرهوا العصيان والانشقاق. مازالت الأسباب والقوى المغذية لهذه النزعة التوحيدية أمرا يتجادل حوله الباحثون، يقدمون حولها افتراضات كثيرة، بعضها مقنع، لكن كلها يعوزه الدليل من المصادر التاريخية والحفريات.
الحضارة النهرية هى أشهر النظريات التى حاولت تفسير نشوء الدولة المركزية المبكر فى مصر. تقول النظرية إن الحياة حول الأنهار تحتاج إلى سلطة عليا تنظم استخدام مياه النهر، وتسيطر عليه فى فترات الفيضان والجفاف، لذا نشأت الدولة المركزية فى أحواض الأنهار. نقاط الضعف فى هذه النظرية كثيرة، فالحفريات التاريخية تشير إلى الكثير من المعابد والمقابر والأهرامات، لكنها لا تشير، إلا نادرا، إلى وجود سدود يعتد بها تخزن المياه، أو ترع وقنوات تنقل المياه إلى الأراضى البعيدة عن النهر. الحفريات تشير إلى وجود مقاييس عديدة للنيل، تقيس ارتفاع الفيضان، وعليه يتم تحديد مقدار الضرائب المقدرة على الفلاحين. الدولة النهرية هى نظرية مستمدة من خبرة مشروعات الرى الكبرى التى نفذتها الدولة الحديثة، فافترض أنصار النظرية أن مثل هذه المشروعات كانت موجودة دائما، واستندوا إلى هذا الزعم لتفسير التاريخ المصرى القديم، خاصة تفسير الظهور المبكر للدولة المركزية فى مصر.
يظل النيل مهما فى تفسير ظهور الدولة المركزية فى مصر. لقد سمح النيل بازدهار الزراعة، وانتقال المصريين من الرعى والصيد وقطف الثمار إلى زراعة الأرض. من وقتها وحياة المصريين مرتبطة بالأرض المزروعة التى أصبحت مصدر رزقهم، ولم يعودوا مستعدين للرحيل مع كل نقص فى الموارد أو نزاع مع الجيران، فتحولوا من حياة الترحال إلى حياة الاستقرار، وأصبح الارتباط الشديد بين الفلاح والأرض من أهم خصائص الأمة المصرية.
بالمقارنة مع البدو الرحل، يحتاج المزارعون إلى الأمن أكثر من حاجة الرعاة البدو له. درس علماء الأنثروبولوجيا مجتمعات بدائية كانت موجودة على حالها حتى وقت قريب، فوجدوا أن الصراعات بين قرى المزارعين البدائيين تكون أكثر دموية من الصراعات بين البدو والرعاة الرحل. عندما يتعرض أمن الرعاة للخطر، أو عندما يدخلون فى صراع مع قوة لديها قدرات أكبر منهم، فبإمكان الرعاة الرحل قيادة قطعانهم وحمل أدواتهم البسيطة والرحيل إلى مكان بعيد يعيدون فيه إقامة حياتهم غير المعقدة. الفلاح بالمقابل لا يمكنه الرحيل عند الشعور بالتهديد وازدياد الخطر. فالأرض وما عليها من محاصيل وأدوات زراعة ثقيلة هى مصدر ثروة الفلاحين، وكلها أشياء لا يمكن لحياة الفلاح أن تستمر دونها، بينما لا يستطيع الفلاحون حملها معهم أينما يذهبوا.
الفلاحون لا يرحلون ولا يهربون، لكنهم يدافعون عن الأرض، مصدر رزقهم الوحيد، حتى الموت، أوقد يسلمون بالأمر الواقع لو وجدوا أنهم إزاء غزاة أشداء لا قبل لهم بقوتهم، وهو ما حدث مع الغزاة المتفوقين من فرس ورومان وعرب وترك؛ وهذا هو ثمن الحضارة التى أقامها المصريون فى الوادي. فخلافا للرعاة الرحل، لا يترك الفلاحون أرضهم، وهذا هو سر الاستمرارية المصرية عبر التاريخ.
الدولة هى الحل المصرى العبقرى لضرورات إقامة حضارة زراعية فى الوادي. فالدولة لم تنظم النهر كما يزعم أنصار نظرية الدولة النهرية، ولكنها وفرت الأمن للفلاحين، فحلت النزاعات التى تنشأ بين الجيران والقرى، وهى النزاعات التى عادة ما تكون أكثر دموية من النزاعات بين الرحل، أهل الكر والفر، إذا كر أحدهم فر الآخر، فيتجنبون سقوط أعداد كبيرة من الضحايا. وبالإضافة إلى حل النزاعات ومنع تصعيدها، فإن الدولة تحمى البلاد كلها ضد هجمات الغزاة الأجانب.
فترات الضعف فى التاريخ المصرى هى الفترات التى ضعفت فيها الدولة، فانعدم الأمن وانتشر عدم الاستقرار وسادت النزاعات. لا يسجل التاريخ أن المصريين عانوا فى أثناء فترات ضعف الدولة من نقص الغذاء، أو من الجفاف أو ثورات الفيضان، بقدر ما عانوا النزاعات والنهب، واعتداءات البدو الرحل المتربصين بأهل القرى المستقرين. فى بردية إيبور عن عصر الاضمحلال الأول نقرأ أن إصلاح البلاد فى حاجة إلى ملك حازم، لأن صورة البلاد قد تغيرت، وامتلأت بالعصابات، حتى إن الرجل يذهب إلى حقله ومعه درعه، فالمجرمون والنهابون فى كل مكان.
الدولة جزء لا يتجزأ من الثقاقة السياسية للمصريين، فقد كانت لديهم دائما دولة تحكمهم، تمنوها أن تكون عادلة، لكنهم أدركوا أن وجودها هو دائما أفضل من غيابها. الدولة تجلب معها النظام والأمن، وهو أهم ما يحتاجه المزارعون. المصريون، ومعهم أمم الفلاحين العريقة فى الصين والهند، يكرهون انعدام الأمن ولا يتسامحون مع الفوضى، ولهذا فهم يتطلعون دائما إلى الدولة.