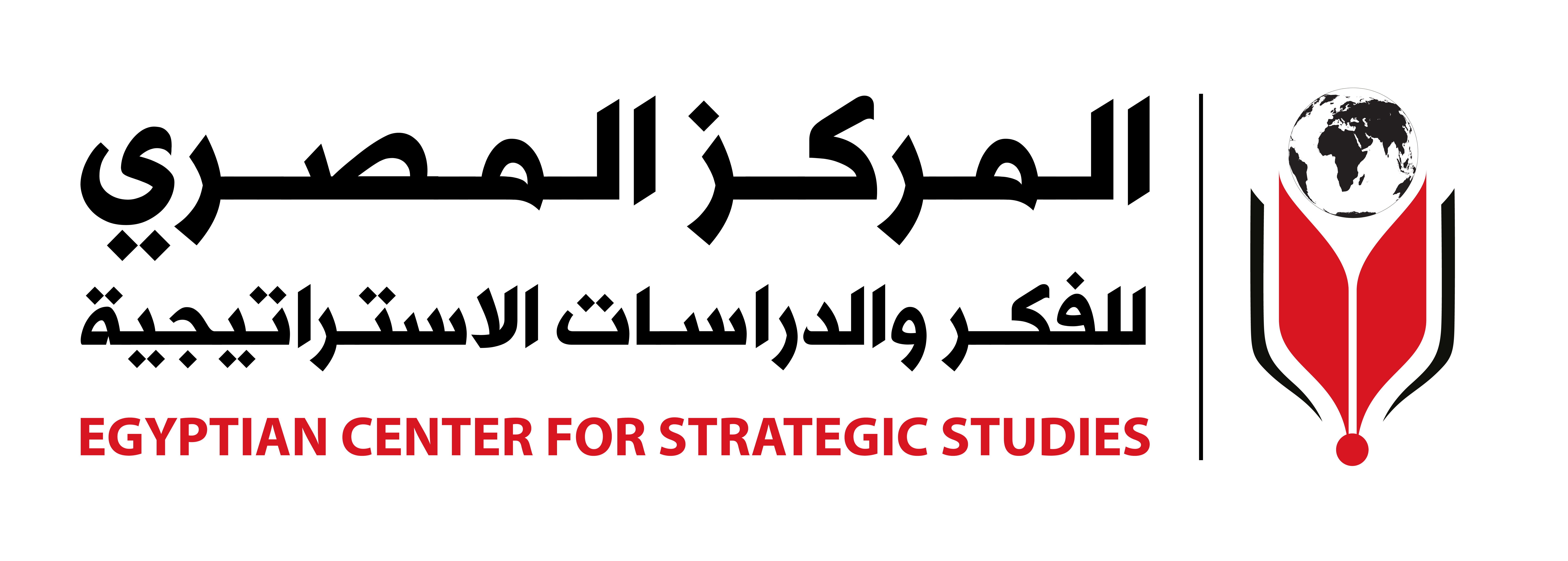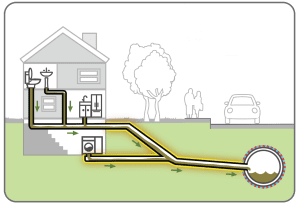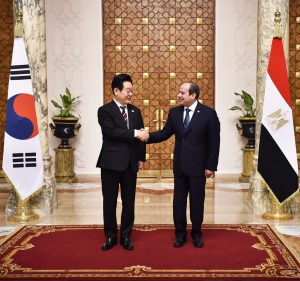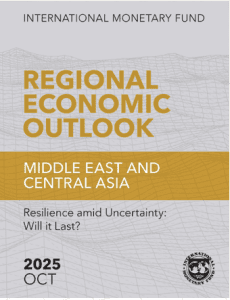تراجُعُ دور الدولة في الاقتصاد، وتَزَايُدُ دور القطاع الخاص.. ذلك هو التكليف الرئاسي الذي تم الحديث عنه لمرات عدة منذ مؤتمر الأسرة المصرية في رمضان من العام الحالي، والذي تم خلاله إعلان وضع مصر لخطتها لمشاركة القطاع الخاص والتوسع فيها لتزيد مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات إلى 65 % في غضون ثلاث سنوات، وهو ما يعني إقدام الدولة على إعادة توجيه استثمارات القطاع الخاص بما يحقق أهداف التنمية المستدامة في رؤية مصر 2030.
إتاحة المجال لمشاركة القطاع الخاص في التنمية لا يعني أن تتنازل الدولة عن دورها في الاقتصاد، بل إنه برنامج يعتمد على التعاون تساعد فيه الدولة عبر توجيه استثمارات القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية في رؤية مصر 2030. وعادة ما يتم ذلك من خلال توسع الدولة في الحصول على تمويل مختلط أشبه بما تقوم به الدولة عند إصدارها للسندات الخضراء التنموية، أو إعادة توجيه القطاع الخاص من خلال توجيه استثماراته إلى قطاع مستهدف، لكن تلك العملية ليست يسيرة، إذ إنها تحتاج إلى حشد لرأس المال، مع إتاحة جميع أنواع التمويل التي على رأسها رأس المال والديون.
تسعى الدولة المصرية إلى تحقيق مرادها من خلال عدة استراتيجيات يأتي في مقدمتها إشراك القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال تجهيز قائمة طروحات حكومية لتخارج الدولة من تلك القطاعات، وتفسح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص للأخذ بزمام الأمور وتطوير الأعمال. أما البُعد الآخر من الاستراتيجية فيتمثل في تعاون مصر مع مؤسسات التنمية الدولية لجذب مستثمرين محليين ودوليين، خاصة في العديد من القضايا التي تتعلق بالمساواة بين الجنسين والمناخ والقطاعات الاجتماعية المختلفة، خاصة وأن إشراك المستثمرين المحليين في تلك المجالات يعد أمرًا ليس باليسير. لكن لتحقيق تلك الأهداف المصرية فإن الأمر يحتاج إلى بذل مزيد من الجهد في الارتقاء بالعنصر البشري، حيث إن بناء رأس المال البشري هو أمر ضروري للاستفادة من الموارد المتاحة، ودون العنصر البشري لا يمكن أن يكون هناك جذب لاستثمارات من القطاع الخاص داخل الاقتصاد المصري. الأمر الثاني هو تقليل الحواجز التجارية، حيث إن إصلاح التجارة أمر يساهم في بناء روابط أفضل، خاصة وأن العملية التجارية في مصر خاصة تلك العابرة للحدود تتسم بالتعقد الشديد وطول وقت الإجراءات. أمر آخر تم الحديث عنه في مؤتمر الوكالة الأمريكية للتنمية عند حديثها عن كيف تمول مصر سياسات أجندة التنمية المستدامة، وهو زيادة العدالة التجارية، حيث أشارت إلى أن مسألة اليقين والوضوح فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية هو أمر هام لجذب استثمارات القطاع الخاص، في اعتباره منها أن مصر اتخذت خطوات بالفعل في ذلك المجال بعد أن قامت بإقرار قانون الإفلاس منذ سنوات. نقطة أخرى وهي تحقيق التوازن بين مشاركة الدولة والقطاع الخاص، حيث إنه لا يجب على الدولة أن تتنافس مع القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، حيث إن تلك القضية هي قضية رئيسية يجب حلها لتشجيع الاستثمار.
يوجد لدى الحكومة ما لا يقل عن خمسة مشروعات رئيسية قيد الإعداد سيتم طرحها وفقًا لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتتضمن تلك المشروعات محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، ومحطة لتحلية المياه، و8 محطات جديدة لتحويل المخلفات إلى طاقة، ومستشفى في مدينة العبور، وسلسلة من الموانئ الجافة الجديدة، والمستودعات في الصعيد، لكن المثير في الأمر هو أن هناك عدد 64 شركة تسعى للتقدم بعروض للمنافسة في المشروعات.
من جانب آخر، تسعى الحكومة للتوسع في مشاركة القطاع الخاص في مجال التعليم من خلال إعادة إحياء برنامج إنشاء المدارس بالشراكة مع القطاع الخاص، والذي تم تأجيل التنفيذ الفعلي له لفترة طويلة، إذ تخطط الحكومة لبناء 1000 مدرسة جديدة في جميع أنحاء البلاد ضمن ذلك الإطار التعاوني بين القطاعين العام والخاص، حيث توفر الحكومة للشركات الأراضي والتراخيص اللازمة، وتشارك الشركات بتمويل عمليات الإنشاء والتشغيل. ومن الجدير بالذكر أن المرحلة الأولى من ذلك البرنامج واجهت صعوبات كبيرة بعد أن أدت المشكلات الهيكلية المتعلقة بعملية طرح المناقصات في تقدم عدد محدود من المستثمرين، لكنّ هناك آمالاً كبيرة على تجاوز تلك المشكلات خلال المرحلة الثانية والتي تتضمن طرح 57 – 65 مدرسة جديدة لنظام المشاركة.
لكن ولتحقيق تلك الأهداف التي تسعى لمشاركة أكبر من القطاع الخاص، فهناك حاجة إلى توفير حزمة من المشروعات المتنوعة التي تشمل مجالات عدة وتوزيعًا متنوعًا للأعباء المالية بين القطاعين العام والخاص، على أن تشمل قطاعات المشاركة مشروعات متنوعة في مجال البنية التحتية، مثل: الطرق، ومحطات معالجة الصرف الصحي، والمدارس والمستشفيات، ويمكن أن تكتمل تلك الشراكة من خلال توفير مناهج جديدة وهياكل جديدة لنظم المشاركة بين القطاعين، تتضمن توفير مخاطر أقل بالنسبة للمستثمرين، حيث إن أي مشروع استثماري ينطوي على مجموعة من المخاطر الفنية والتشغيلية، بالإضافة إلى مخاطر السوق، حيث أبدى المستثمرون قدرتهم على إدارة المخاطر الفنية والتشغيلية للمشروع، لكنهم طلبوا أن تتشارك الحكومة في تحمل جزء من المخاطر المرتبطة بالمشروع التي لا يمكن السيطرة عليها والتي تتمثل في مخاطر التضخم، وتقلب أسعار العملات، ومخاطر الرسوم التي يدفعها لاعبو القطاع الخاص مقابل الخدمات الحكومية مثل (المياه والكهرباء). فعلى سبيل المثال، قد يحصل المطورون للقطاع الخاص على قروض بعملات جانبية لتنفيذ المشروعات التي يتم تنفيذها مع الحكومة، ومن ثم فإن أي خفض لقيمة الجنيه يهدد قدرتهم على إعادة سداد تلك القروض، ومن ثم فإن أحد الحلول المطروحة لتلك المخاطر المتمثلة في سعر الصرف هو قيام الحكومة بسداد جزء أو كل من أتعاب المشروع لمقاولي القطاع الخاص بالعملات الأجنبية، وهو ما سيسمح بتوفير السيولة المطلوبة بالعملة الأجنبية لسداد القروض ومن ثم يخفض من مخاطر سعر صرف العملة، وسيمهد الطريق بشكل أكبر لمؤسسات التمويل الأجنبية للعب دور أكبر في عمليات تمويل التنمية في مصر، إذ إن تلك المؤسسات قادرة على توفير تمويلات تنموية لآجال طويلة تصل إلى ثلاثين عامًا في حال ضمنت الحكومة سداد جزء من أعباء تلك الخدمات بالعملات الأجنبية.
من ناحية أخرى، فإن الطبيعة الاقتصادية والتشغيلية لمشروعات البنية التحتية فريدة من حيث الآجال والسيولة، حيث إن اقتصاديات تلك المشاريع تمتد إلى آجال طويلة قد تتجاوز 15 إلى 20 عامًا لتحقيق عوائد جيدة على الاستثمار بها، هذا فضلًا عن أن جزءًا كبيرًا من مكونات تلك المشروعات يتم شراؤها من الخارج (استيرادها) بعملات أجنبية، وهو ما لا يتوافق مع طبيعة المخاطر والسيولة للبنوك المصرية إذ لا تحبذ المصارف المصرية تقديم تمويلات بعملات أجنبية ولآجال طويلة، بعكس دور مؤسسات التمويل الدولية وقدرتها على القيام بذلك الدور. نقطة أخرى يمكن الإشارة إليها هي أن مؤسسات التمويل التنموية الدولية تزود المؤسسات التنموية للحكومات بالمساعدة الفنية التي تساعد في تحديد وتقييم المشروعات الأكثر ملاءمة لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال تقديم المشورة للحكومات بشأن اللوائح التي تحكم مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
نماذج مصرية ناجحة
كان لقطاع النقل المصري نصيب الأسد من الاستثمارات التي تم ضخها بنظام المشاركة بين القطاعي العام والخاص، إذ تم إنفاق 5.23 مليارات دولار حصل قطاع النقل على حوالي 5 مليارات دولار منها، وذلك وفقًا لبيانات البنك الدولي عن كل دولة، وتمثلت أهم الاستثمارات في ذلك القطاع بمشروع لقطاع السكك الحديدية، ومشروع القطار الكهربائي السريع الذي تم استثمار مبلغ 4.5 مليارات دولار (تم الاتفاق عليه في عام 2020) ويتم تنفيذه من خلال تحالف يضم سيمنز موبيليتي وأوراسكوم كونستراكشون والمقاولون العرب، بالتعاون مع الهيئة القومية للأنفاق.
نموذج مصري آخر لنجاح تلك الشراكة يتمثل في محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية والتي تم توقيع اتفاقية الشراكة بها خلال العام الماضي بتكلفة 165 مليون دولار، وهي محطة طاقة شمسية بقدرة 200 ميجاوات، يتم تنفيذها بالتعاون بين شركة الطاقة المتجددة السعودية أكوا باور، والشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بموجب إطار عمل البناء والامتلاك والتشغيل لمدة 25 عامًا، وقد حصل المشروع على تمويله من خلال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأفريقي للتنمية.
ليست تلك هي المشروعات الوحيدة التي نفذتها الدولة المصرية بنظام الشراكة، فلدى مصر قصص نجاح كبيرة في مجال معالجة النفايات والصرف الصحي، مثل محطة معالجة مياه الجبل الأصفر بتكلفة 49 مليون دولار، بموجب عقد مدته أربع سنوات، تتولى شركة البنية التحتية الفرنسية “سويز” والمقاولون العرب إدارة المحطة وتنفيذ الأعمال لتحسين كفاءتها في استخدام الطاقة. وتبلغ سعة المحطة مليون متر مكعب يوميًا، وتعالج مياه الصرف الصحي لما يقرب من 5 ملايين شخص من سكان القاهرة الكبرى. ولا زال هناك الكثير أمام القطاع الخاص للوصول إلى النسبة المستهدفة من جانب الحكومة المصرية، ويعتبر قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص إيجابيًا للغاية من الناحية التنظيمية، وفي انتظار اللائحة التنفيذية للقانون التي يُنتظر أن ترى النور قريبًا، إذ ستسمح تلك اللائحة التنفيذية للقطاع الخاص باقتراح مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال لجنة خاصة تضم ممثلين من القطاعين.
نائب رئيس وحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة