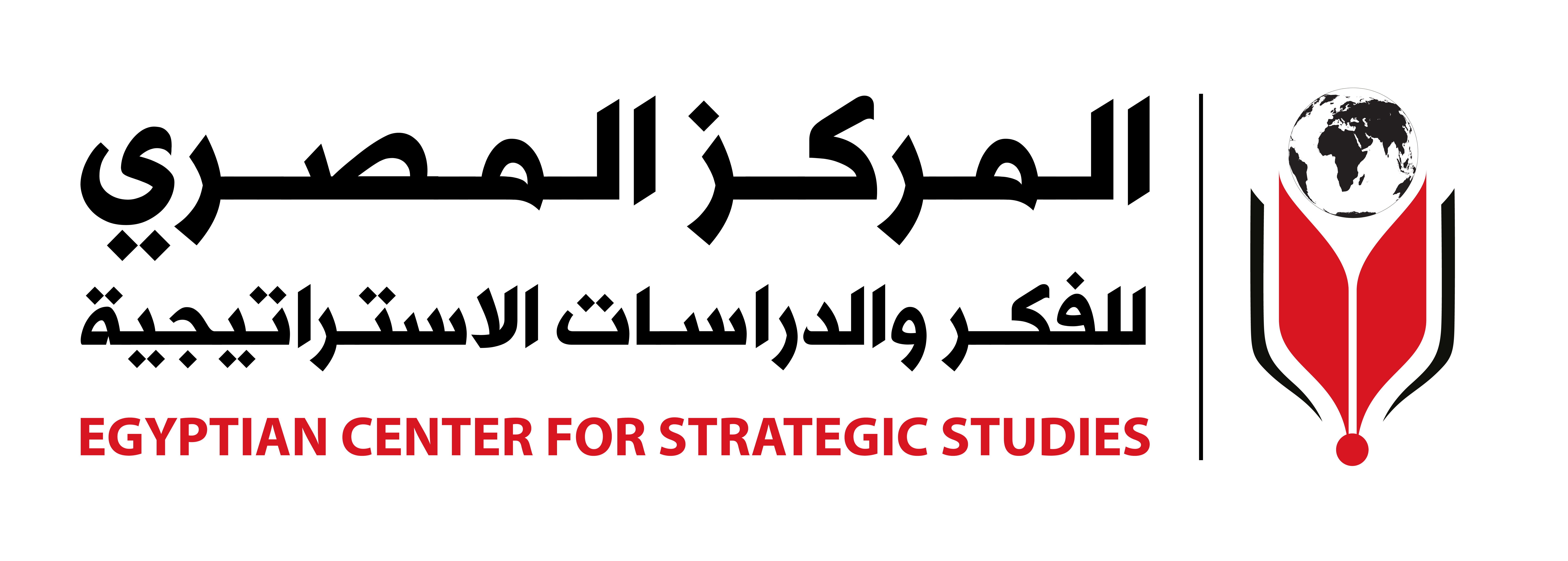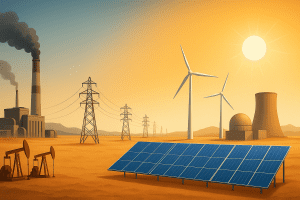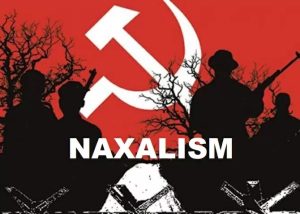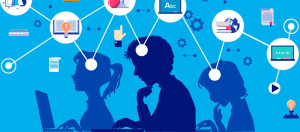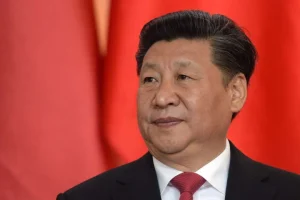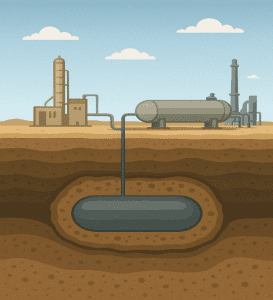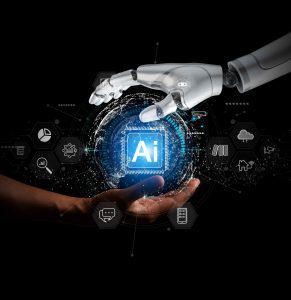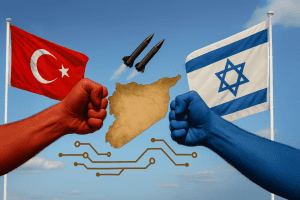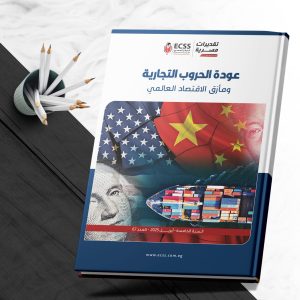أطلقت الدولة المصرية العديد من الاستراتيجيات الوطنية الموجهة بشكل أساسي لتحقيق هدفي التنمية والتمكين للمجتمع في ضوء رؤية مصر 2030. وركزت أغلب الاستراتيجيات أهدافها حول تحقيق التنمية المستدامة للفئات الأولى بالرعاية (المرأة، الطفل)، وتقليص الفجوة بين الجنسين. وفيما يلي عرض مختصر لنتائج أبرز تلك الاستراتيجيات:
الاستراتيجية الوطنية للسُكان والتنمية
تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للسُكان والتنمية في عام 2014 “الخطة التنفيذية (2015_2020) ” في إطار تكليف رئاسي لوزارة الصحة والسُكان بوضع قضية السُكان والتنمية على رأس أولويات عمل الوزارة، وتم تحديث الاستراتيجية عام 2023 “الخطة التنفيذية (2023_2030)”، لتواكب التغيرات التي حدثت، خاصة من خلال تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والنمو الاقتصادي.
تتضمن الاستراتيجية الوطنية للسُكان والتنمية 7 محاور: ضمان الحقوق الإنجابية، الاستثمار في الطاقة البشرية، دعم دور المرأة، التعليم والتعلم، الاتصال والإعلام من أجل التنمية، السُكان والبيئة “التغيرات المناخية وديناميكية السُكان”، حوكمة الملف السكاني.
وتتمحور رؤية الاستراتيجية حول تحقيق التوازن بين السُكان والتنمية من خلال: تعزيز الصحة الإنجابية، تمكين المرأة، الاستثمار في الشباب، تحسين فرص التعليم، رفع الوعي بالقضايا السُكانية، تحقيق الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين.
تقييم الاستراتيجية الوطنية للسُكان والتنمية (2015-2020)
تُشير اتجاهات المؤشرات في مصر إلى مدى العقود الماضية إلى إحراز تقدم ملحوظ في بعض المحاور وتراجع في محاور أخرى:
- معدل الإنجاب الكلي:
تُشير نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 إلى أن معدل الإنجاب الكلي (لفترة الثلاث سنوات السابقة على إجراء المسح) قد وصل إلى 2.85 طفل لكل سيدة والذي يمثل انخفاضًا عن المستوى الذي تم رصده في سنة 2014 بحوالي 0.7 طفل (بلغ المعدل 3.5 أطفال لكل سيدة في المسح السُكاني الصحي 2014). ويلاحظ انخفاض معدل الإنجاب بصفة عامة لجميع فئات العمر للسيدات، وذلك وفقًا لأهم نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 2022.

كما تشــير النتائج إلى أن ثلثــي الســيدات المتزوجــات حاليــًا فــي العمــر مــن 49-15 يســتخدمن وســيلة لتنظيم الأسرة بزيــادة حوالي 8 نقــاط عن المســتوى الــذي تم رصده في المســح الســكاني الصحي 2014. وتصل نسبة مستخدمات الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة فــي 2021 إلى 65%، مقارنــة بحوالــي 57% فــي 2014.

- وفيات الأطفال
أشارت نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 أن معدل وفيات الأطفال الرضع خلال الخمس سنوات السابقة على المسح بلغ 25 حالة وفاة لكل 1000 مولود، ومعدل وفيات الأطفال حديثي الولادة 18 حالة لكل 1000 مولود، بينما وصل معدل وفيات ما بعد حديثي الولادة (بعد الشهر الأول) إلى 7 حالات لكل 1000 مولود حي. وقد وصل معدل وفيات الأطفال دون الخامسة إلى 28 حالة لكل 1000 مولود حي. وتمثل وفيات الرضع حوالي 89% من وفيات الأطفال في مصر، وحوالي 72% من وفيات الرضع تحدث خلال الشهر الأول بعد الولادة.
وتشير بيانات المسح مقارنة بالمعدلات التي تم رصدها في المسح السكاني الصحي 2014 إلى حدوث ارتفاع في معدل وفيات الرضع من 22 حالة وفاة لكل 1000 مولود في 2014 إلى 25 حالة وفاة في، 2021 وكذا معدلات وفيات الأطفال خلال الشهر الأول من 14 حالة لكل 1000 مولود في 2014 إلى 18 حالة في 2021، بينما انخفض معدل وفيات الأطفال من 1-4 سنوات من 5 حالات لكل 1000 مولود إلى 3 حالات فقط.

ووفقًا لدراسة ديموغرافية حملت عنوان “وفيات الرضع بدول حوض النيل”، تعددت العوامل المؤثرة في وفيات الرضع، لتشمل مجموعة المتغيرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، والمتغيرات المتعلقة بحالة التغذية، والمتغيرات الصحية؛ وإجمالي الإنفاق على الصحة للفرد ومعدل الخصوبة، وفيات الأطفال حسب النوع، نسبة الفقر متعدد الأبعاد وغيرها من العوامل المؤثرة. وبالعودة إلى المؤشرات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نجد أن البيانات تُشير إلى ارتفاع نسبة المصابين بالأنيميا بين 2014 و2021، حيث ارتفعت النسبة بين الأطفال من عمر 6 -59 شهرًا من 27.2 إلى 43%، وتصل نسبة الأنيميا البسيطة إلى 20% مقارنة بحوالي 18% عام 2014.

ما لم تحققه الاستراتيجية
لا تزال هنــاك فجــوة بيــن الذكــور والإناث فــي الكثيــر مــن المؤشــرات مثــل معدلات الأمية، والبطالــة، فبالرجوع للمؤشرات الحديثة وُجد أن معدل بطالة الإناث قد وصل في الربع الثالث من 2023 إلى نحو 17.2% مقابل 4.8% للذكور، متراجعًا بنحو 1.9 نقطة مئوية عن الربع الثالث من عام 2022 ومرتفعًا بنحو 1.9 نقطة مئوية عن الربع الثالث عام 2021. كذلــك أوضحــت نتائــج المســح الصحــي للأسرة المصريــة لعــام 2021 أن %17.5 فقــط مــن النســاء الســابق لهــن الــزواج وتتــراوح أعمارهــن بيـن 15 و49 عامـًا يعملـن حاليًـا أو قمـن بـأي عمـل خلال الاثني عشـر شـهرًا السـابقة علـى المســح، و%65 فقــط مــن الســيدات يشــاركن فــي القــرارات الخاصــة برعايتهــن الصحيــة وشــراء طلبــات كبيــرة للأسرة وزيــارة العائلــة والأقارب، وتوثــق البيانــات وجــود علاقة طرديــة بيــن تمكيــن المــرأة واســتخدام وســائل تنظيــم الأسرة، فترتفــع نســبة اســتخدام وســائل تنظيــم الأسرة بيــن الســيدات اللاتي يعملــن مقابــل عائــد نقــدي لتصــل إلى 71 %مقابـل 66% بيـن اللاتي لا يعملن مقابـل عائـد نقـدي، وتنخفـض نسـبة اسـتخدام وسـائل تنظيــم الأسرة بيــن النســاء اللاتي لا يشــاركن فــي أي قــرارات خاصــة بالأسرة (61%) عنــه عمن يشاركن في قرار واحد على الأقل.
- تنظيم عملية الزيادة السُكانية
توالت الزيادات السريعة لعدد السكان خلال القرن العشرين وبدايات القرن الحالي فقد بلغ عدد السكان عام 1897 حوالي 9.7، ليصل عدد السكان إلى 11.39 مليون نسمة بمعدل نمو 1.43% عام 1907، وإلى 12.7 في عام 1917 بمعدل نمو قدره 1.31%، ووصلت إلى 14.2 مليون نسمة في عام 1927 بمعدل نمو 1.10%. وفي عام 1937 وصل عدد سكان مصر إلى 15.9 مليون نسمة بمعدل نمو قدره 1.15. وفي عام 1947 قفز عدد السكان إلى 18.9 مليون بمعدل نمو 1.75%، وفي عام 1960 وصل عدد السكان 26.1 بمعدل نمو قدره 2.30%. وقفز عدد السكان إلى 36.6 مليون نسمة عام 1976 بمعدل نمو قدره 2.12%. وفي عام 1986 وصل عدد السكان إلى 48.3% مليون نسمة بمعدل نمو 2.86%. وفي عام 1996 وصل عدد السكان إلى 59.3 مليون نسمة، بمعدل نمو قدره 2.06%. بينما بلغ عدد السكان 72.8 مليون عام 2006 بمعدل نمو سنوي قدره 2.05% ووصل عدد السكان إلى 89.6 بمعدل نمو قدره 2.30% عام 2015، بينما وصل عدد السكان إلى 94.8 مليون نسمة عام 2017 بمعدل نمو قدره 2.5%. ليصل عدد السكان عام 2020 إلى 101 مليون نسمة بمعدل نمو قدره 1.7%.
ومما سبق يتضح اتجاه عدد المواليد السنوي خلال الفترة من 2000 إلى 2019 أن الثبات في عدد المواليد -والذي ظل سائدًا عند مستوى 1.8 مليون مولود سنويًّا في السنوات الخمس الأولى- أعقبه اتجاه إلى الزيادة بدءًا من عام 2006 ليصل إلى 2.7 مليون مولود عام 2014 و2015 وتراجع لمستوى 2.6 مليون مولود في عامي 2016 و2017، ليواصل التراجع بعد ذلك حتى وصل إلى 2.3 مليون عام 2019.
أعداد المواليد في مصر خلال الفترة من 2000 إلى 2019

قام قسم السكان بالأمم المتحدة بإعداد إسقاطات سكانية دورية لكل دول العالم، وفقًا لمنهجية واحدة تسمح بالمقارنات الدولية، ويتم تحديث هذه الإسقاطات السكانية دوريًا وفقًا لنتائج التعدادات أو المسوح السكانية التي يتم عملها. وفي إصدارة 2012 قدّر مكتب السكان بالأمم المتحدة أن عدد سُكان مصر سيصل بحلول عام 2030 إلى 102.6 مليون نسمة، ويصل بحلول عام 2050 إلى 121.8 مليون نسمة، إلا أن الإصدارة الأخيرة لمكتب السكان رجّحت وصول مصر بحلول عام 2030 إلى 120.8 نسمة والى 160 مليوًنا بحلول عام 2050.

استراتيجية الحد من الزواج المبكر (2015-2020)
وفقًا لتعداد عام ۲۰۱۷ في مصر، لا يزال الزواج المبكر مشكلة؛ ففي مصر فإن واحدة من كل عشرين فتاة تقريبًا ممن تتراوح أعمارهن ما بين ۱٥ و۱۷ عامًا متزوجات حاليًا أو كن متزوجات فيما سبق، في حين نجد أن هذه النسبة تصل إلى واحدة من كل عشر مراهقات ممن تتراوح أعمارهن ما بين ۱٥ و۱۹ سنة، مع وجود تباين كبير بين المناطق الريفية والحضرية.
ويتبلور الهدف الاستراتيجي العام حول خفض نسبة الزواج المبكر إلى نصف المستوى الحالي في خلال خمس سنوات، من التركيز على المناطق الجغرافية التي تشيع فيها الظاهرة.
كما أفادتالاستراتيجية القومية للحد من الزواج المبكر، بأن معدل الزواج المبكر بلغ 15% من إجمالي الزيجات عام 2015، وذلك طبقًا لمكتب مرجع السكان” PRB”. وبلغت نسبة الفتيات المتزوجات بين 15-19 عامًا نحو 13% وفقًا للمسح الصحي المصري لعام 2008. ويمكن أن نرجع استناد الاستراتيجية لمعلومات مكتب مرجع السكان لعدم وجود دراسة قومية في هذا المجال، إلا أن البحوث المتناثرة في المحافظات الأكثر فقرًا، والمناطق الجغرافية التي تنتشر بها هذه الممارسات أثبتت أن الظاهرة في ازدياد.
ما لم يتم تحقيقه
في أحدث مسح صحي تم إصداره في عام 2021 بلغت نسبة المتزوجات دون سن الثامن عشرة في الفئة العمرية من 20-24 حوالي 16%. وبالتالي نستنتج أن الاستراتيجية القومية للحد من الزواج المبكر لم تحقق النجاح المنشود في خفض نسبة المتزوجات دون سن الثامن عشرة إلى النصف عند انتهاء مدة الاستراتيجية.

المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
يمثل المشروع خطة استراتيجية تم إعدادها من قِبل عدد من الوزرات والجهات وأُطلقت في فبراير 2022، حيث تم تنظيم الاقتراحات ووضعها في إطار تنفيذي من خلال 5 محاور رئيسية، تتمثل في :
- محور التمكين الاقتصادي:
يقوم على مخرجات برامج 2 كفاية، وتكافل وكرامة، وفرصة، كما يستهدف تمكين السيدات في الفئة العمرية 18- 45 سنة من العمل وكسب الرزق والاستقلالية المالية، ومن خلال ذلك سيتم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسيدات اللاتي يلتزمن باستخدام وسائل تنظيم الأسرة وسيتم تدريبهن كذلك على عملية الإدارة. - محور التدخل الخدمي
يهدف إلى خفض الحاجة غير المُلباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، وذلك من خلال تعيين طبيبات مُدربات على وسائل تنظيم الأسرة، وتوزيعهن على المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية. - محور التدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي
يستهدف رفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، ويتضمن المحور إضافة مكون تعليمي في المناهج المدرسية والجامعية لتوعية الطلاب. - محور التحول الرقمي
يهدف إلى بناء قاعدة بيانات متكاملة لخدمات تنظيم الأسرة حيث يتم السعي من خلالها للوصول الذكي للسيدات المستهدفات لتقديم الخدمة وتسهيلها ومتابعتها وتقييمها، بالإضافة إلى تدشين المرصد الديمغرافي لمتابعة كافة المؤشرات السكانية والاستعانة بها لصناعة القرار. - المحور التشريعي
تتم دراسة التعديلات المقترحة لقوانين: العقوبات، والأحوال المدنية، والطفل، والتعليم، والاستثمار، لأخذها في الاعتبار في المحور الخامس في المشروع، والخاص بالتدخل التشريعي حيث يستهدف وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني يهدف إلى التعامل مع بعض الظواهر المسببة لزيادة السكان كعمالة الأطفال وزواج القاصرات والزواج المبكر، وعدم تسجيل المواليد.
** تم إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في فبراير 2022- 2023، ولم يُستدل على بيانات حديثة من فبراير 2022 وحتى فبراير 2023 لقياس مدى تحقق الأهداف المُعلنة.
الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية (2017- 2030)
ترتكز رؤية استراتيجية تمكين المرأة 2030 على أنه بحلول عام 2030 تصبح المرأة المصرية فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة في وطن يضمن لها كافة حقوقها التي كفلها الدستور، ويحقق لها حماية كاملة ويكفل لها -دون أي تمييز- الفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمكنها من الارتقاء بقدراتها وتحقيق ذاتها، ومن ثَمّ القيام بدورها في إعلاء شأن الوطن.
أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030
تسعى الاستراتيجية إلى التأكيد على التزام مصر بحقوق المرأة ووضعها موضع التنفيذ وفقًا لما أقرته المواثيق الوطنية على راسها الدستور المصري، والاتفاقيات والمواثيق والإعلانات الدولية التي التزمت بها مصر. كما تسعى الاستراتيجية إلى الاستجابة للاحتياجات الفعلية للمرأة المصرية، خاصة المقيمة في ريف الوجه القبلي، والفقيرة، والمعيلة، والمسنة، والمعاقة، باعتبارهن الفئات الأولى بالرعاية، عند وضع الخطط التنموية من أجل توفير الحماية الكاملة لهن والاستفادة الكاملة من الطاقات والموارد لبشرية والمادية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص كما نص عليه الدستور. وفيما يلي منجزات الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية على صعيد الأربع محاور:
- محور التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة
استحوذت المرأة على 165 مقعدًا في مجلس النواب عام 2021 حيث تمكنت من حصد 148 مقعدًا بالانتخاب (142 مقعدًا بنظام القائمة، و6 بالنظام الفردي)، وتم تعيين 14 سيدة مثلن 50% من إجمالي المعينين وعددهم 28 نائبًا، فضلًا عن تصعيد 3 سيدات ضمن القائمة الاحتياطية بعد وفاة 3 نواب. تترأس المرأة لجنتين من إجمالي 25 لجنة نوعية بالبرلمان، وتشغل 7 سيدات منصب الوكيل للجان الفرعية. وبذلك بلغت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان نحو 28%.
وبلغت نسبة زيادة عدد القاضيات بالمحاكم المصرية، نحو 57.1% ليصل العدد نحو 66 قاضية. بالإضافة إلى تعيين 4 قاضيات منصة لمحاكم الجنايات ورئيسة للمحكمة الاقتصادية، وأول قاضية ترأس دائرة مدنية من دوائر محاكم الاستئناف العالي ونائبة للمحكمة الدستورية العليا للمرة الثانية وتعيين 6 قاضيات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة. علاوة على تعيين 11 سيدة بهيئة قضايا الدولة كرئيسات لمكاتب الهيئة بالمحافظات. على صعيدٍ آخر تراجعت نسبة تمثيل المرأة في التشكيل الوزاري الحالي لحكومة د. مصطفى مدبولي لتصبح 6 سيدات بدلًا من 8 سيدات عام 2021، بينما ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية في مجالات عدّة، حيث وصلت المرأة لمنصب أول مستشارة للأمن القومي لرئيس الجمهورية، ومنصب المحافظ في محافظتين، وتقلدت منصب أول نائبة لمحافظ البنك المركزي. كما وصلت نسبة الدبلوماسيات إلى 25% و40% ممن يعملن بالأعمال الإدارية بوزارة الخارجية.
وفيما يلي توضيح لمحور التمكين السياسي للمرأة حيث يشير اللون الأخضر لتحسن المؤشر، والأصفر لثبات المؤشر والأحمر لتراجع المؤشر وفقًا لمرصد المرأة المصرية.

** ارتفعت نسبة الوزيرات من 12% عام 2017 إلى ضعف هذه النسبة في الفترة من 2017 إلى 2022 حيث بلغت 24% ثم انخفض بعد التعديل الوزاري عام 2022 لتصل إلى 18% ثم انخفض في الحكومة الحالية 2024 لتصل إلى 4 وزيرات أي تقريبًا 12.9%.
- محور التمكين الاقتصادي
تؤكد معظم المؤشرات التي تقيس عدم المساواة بين الجنسين تدني ترتيب مصر فيما يتعلق بالمشاركة والفرص الاقتصادية المتاحة للنساء. فوفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي 2023، فقد حققت مصر درجة تكافؤ بين الجنسين بنسبة 62.6% وبذلك احتلت المرتبة 134 بين 146 دولة شملها التقرير لهذا العام، والمرتبة 10 من بين 13 دولة على مستوى الإقليم، بتراجع قدره 1.3 نقطة مئوية عن المستوى الذي حققته في عام 2021 (63.9%) والذي اعتبر تقدمًا ملحوظًا مقارنة بعام 2017 الذي تراجع فيه مؤشر الفجوة بين الجنسين في مصر إلى 60.8 %.
مقارنة بعام 2021، تراجع المؤشر الفرعي للتحصيل التعليمي بنسبة 3 نقاط مئوية وذلك على إثر التدهور في فرص الالتحاق بالتعليم الثانوي والعالي. بينما استقر المؤشر الفرعي للصحة والبقاء على قيد الحياة عند٪96.8 دون تغيير تقريبًا.
كما جاءت مصر من ضمن مجموعة الدول الأقل تقدمًا في سد الفجوة بين الجنسين فيما يتعلق بالدخول المكتسبة، حيث سجلت 19.7% درجة تكافؤ فقط.

وبمراجعة البيانات السابقة، نجد تراجع ترتيب مصر سواء في المؤشر الكلي للتكافؤ بين الجنسين، أو في المؤشرات الفرعية الخاصة بالتحصيل التعليمي والمشاركة السياسية، ورغم أن التحسن في ترتيب باقي المؤشرات الفرعية طفيف كما يتضح من الجدول، فإن مصر حققت تقدمًا ملموسًا في بعض المجالات انعكس في قيمة المؤشرات الفرعية. فبالنسبة للمشاركة الاقتصادية والفرص المتاحة أمام المرأة، فقد أدت زيادة حصة النساء في المهام الوظيفية العليا بنحو 6.8 نقطة مئوية (حصة المرأة 12.4%) وفي المناصب الفنية بنسبة 4.3 نقطة مئوية (حصة المرأة 35.1%) منذ عام 2022 إلى تعزيز تكافؤ هذا المؤشر الفرعي بنسبة 1.7 نقطة مئوية إلى 42%، ومع التمثيل النسائي المتزايد في مجلس النواب المصري بنحو %27.5 والتشكيل الوزاري للحكومة المصرية بنحو 18.8% أصبح هناك تكافؤ بنسبة 17.5% في التمكين السياسي بمصر.
ووفقًا لمرصد المرأة المصرية جاءت المؤشرات وحالتها كالآتي حيث يشير اللون الأخضر لتحسن المؤشر، والأصفر لثبات المؤشر والأحمر لتراجع المؤشر:

** انخفضت نسبة المساهمة الاقتصادية للمرأة من 23.6% عام 2016 إلى 14.9% عام 2022.
** تراجع مؤشر الدخل المكتسب المقدر والذي يشير إلى إجمالي دخل النساء (داخل وخارج قوة العمل) حيث انخفضت النسبة من 29% عام 2016 إلى 19.7% عام 2023.
- محور التمكين الاجتماعي

**تلاشت الفجوة في معدل التحاق بالتعليم بين الذكور والإناث في التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي، كما بلغت نسبة الطالبات %54.8 من إجمالي الطلبة والطالبات بالثانوي العام.
** ارتفعت نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة من %58.5 في عام 2014 إلى %66.4 عام 2021، وهو ما يشير إلى اقتراب مصر من تحقيق المستهدف في عام 2030 وهو الوصول بنسبة الاستخدام إلى %72، ويمكن تحقيق ذلك بصور سريعة من خلال تلبية الحاجات غير الملباة لوسائل تنظيم الأسرة والتي ارتفعت نسبتها من 12.6% عام 2014 إلى 14% عام 2021.
- محور الحماية
لـم تسـتطع مصر الحدّ من الممارسـات التـي تعزز التمييـز ضـد المـرأة، ســواء فــي المجــال العــام أو داخــل الأسرة، وبالتالــي لــم تحقــق الاستراتيجية أهدافها المتعلقة بالحماية، التي تمثلــت أحــد مظاهرهــا في ظهـور نـوع آخـر وهـو العنـف الرقمـي الــذي تعرضــت لــه 85% مــن النســاء علــى مســتوى العالــم، بــل إن الأمم المتحــدة أعلنـت عمـا أطلقـت عليـه جائحـة الظـل الموازيـة لجائحـة كورونـا فـي إشـارة إلى العنـف المتزايـد ضـد المـرأة إبـان وبـاء كوڤيـد -19.
وتتعـدد أشـكال العنـف التـي تتعـرض لهـا المـرأة مـن عنـف جسـدي ونفسـي ورقمـي، بالإضافة إلى زواج القاصـرات والتحـرش الجنسـي وختـان الإناث. ورغـم اســتراتيجية مناهضــة العنــف ضــد المــرأة التــي صــدرت فــي عــام 2015، أثبتــت دراسـة عام 2017 صادرة عن الجهـاز المركـزي للتعبئـة العامـة والإحصاء حـول ظاهـرة ممارسـة العنـف ضـد المـرأة أن 90% مـن النسـاء تـم ختانهن، و42.5% يتعرضــن للعنــف مــن قبــل أزواجهــن، و35.1% يتعرضــن للعنــف البدنــي، و47.5% للعنــف النفســي، و14.5% للعنــف الجنســي، و%86 مــن النســاء اللاتي تعرضـن للعنـف يعانيـن مشكلات نفسـية، بالإضافة إلى زواج أكثـر مـن ربـع النسـاء المصريـات %27.4 قبـل بلوغهـن سـن 18 عامًـا.
ووفقًا لمرصد المرأة المصرية جاءت المؤشرات وحالتها كالآتي حيث يشير اللون الأخضر لتحسن المؤشر، والأصفر لثبات المؤشر والأحمر لتراجع المؤشر:

وبصفة عامة، لم تتمكن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية من تحقيق التمكين الشامل للمرأة ووضعها في المكانة التي تستحقها، لوجود تحديات لا تزال قائمة والتي يمكن إجمال أبرزها فيما يلي:
- محدوية نصيب النساء في المناصب القيادية: حيث يتسم وجود النساء اللواتي يشغلن وظائف قيادية بأجهزة الحكم المحلي بكونه محدودًا للغاية، فقد عُينت أول محافظة على مدى التاريخ في فبراير 2017 فقط، كما أن وجود المرأة في مناصب قيادية على مستوى المحافظة نادر الحدوث، ولا يوجد سوى عدد محدود من رؤساء الأحياء والعُمد. وتُشير نتائج المسوح التي أُجريت عن تطلعات المرأة المصرية إلى أن 43% من المصريات يتطلعن لشغل المرأة منصب رئيس مجلس الوزراء و42% يتطلعن أن تشغل المرأة منصب محافظ وهو ما حدث مؤخرًا حيث شملت تعيين سيدة واحدة في منصب محافظ، وهو ما يعكس الفجوة بين التطلعات والواقع.
- تزايد معدلات الأمية بين الإناث: وبالرغم من تحقيق إنجاز ملحوظ في سد الفجوة التعليمية فإنه لا يزال القضاء على الأمية بين الإناث أحد أهم التحديات التي تواجهها مصر حيث بلغ نسبة الأمية بين الإناث 30.8% بعدد 10.6 ملايين نسمة.
- الفجوة بين الإناث والذكور في المشاركة في النشاط الاقتصادي: في مقابل الإنجاز الواضح الذي حققته المرأة المصرية في مجال التمكين المعرفي إلا إن البيانات الرسمية تؤكد أن هناك قدرًا من عدم المساواة بين الذكور والإناث في مؤشرات المشاركة في النشاط الاقتصادي حيث لا تتجاوز الإناث ربع إجمالي قوة العمل وترتفع البطالة بين الإناث مقابل الذكور لتصل إلى 21.9%.

وتعمل غالبية الإناث في الأعمال غير مدفوعة الأجر وفي العمل الغير رسمي وبالأخص في الزراعة بما يقارب من 25%، وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتوسيع مظلة التأمين الاجتماعي للمرأة فإنه لا تزال المرأة الريفية تواجه عقبات في الحصول على دخل مناسب وتأمين اجتماعي.
- تزايد معدلات العنف الموجه ضد المرأة: وبالرغم من إلزام المادة 11 من الدستور المصري الدولة بحماية المرأة ضد أشكال العنف فإن نتائج الدراسات التي أجريت في مصر مؤخرًا بينت تعرض 34.1% من النساء السابق لهن الزواج إلى عنف بدني أو جنسي من قبل الزوج، و27.4% قد تزوجن قبل بلوغ الـ 18 عام، و20% من النساء تعرضن لعنف بدني وجنسي على يد أفراد العائلة والبيئة المحيطة منذ بلوغهن 18 سنة. وأشارت دراسة أجراها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء للتكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع في عام 2015 إلى أن خسائر المرأة من العنف باهظة تصل إلى حوالي 2.2 مليار جنيه. وذلك يدل على وجود الحاجة إلى زيادة البرامج التي تدعم المرأة التي تتعرض للعنف بأنواعه، إضافة إلى العمل على تفعيل القوانين الرادعة لذلك وسن تشريعات أكثر صرامة فيما يتعلق بجرائم التحرش حيث تُشير البيانات إلى أن 2.5 مليون سيدة قد تعرضن للتحرش في السنة السابقة لمسح التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة (2015) لتصل تكلفة التحرش في الأماكن العامة سنويًا إلى 571 مليون جنيه.
- إغفال التمكين الثقافي للمرأة: حيث افتقرت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 إلى محور مهم وهو محور التمكين الثقافي للمرأة، فتغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة من خلال القضاء على كافة أوجه الإساءة التي تواجه المرأة المصرية وتصحيح الصورة الذهنية التي تشكلها بعض وسائل الإعلام المصرية، يُعد حجر الأساس لجميع مجهودات الدولة وضمان حقيقي لتفاعل كافة شرائح المجتمع في سبيل تحقيق الهدف المنشود. ناهينا عن أن تغيير ثقافة المرأة تجاه حقوقها وواجباتها ومساعدتها على كسر قوالب الموروثات السيئة المتمثلة في الزواج المبكر والختان واقتصار دور المرأة في الزواج والإنجاب والأعمال المنزلية يكون له عظيم الأثر في نجاح فكرة التمكين.
أيضًا افتقرت الاستراتيجية إلى عنصر الإلزام في تنفيذ التدخلات المنصوص عليها، ويتضح ذلك جليًا في تمكين المرأة ذات الإعاقة على سبيل الذكر وليس الحصر. ويتجلى أهمية ذلك العنصر في المؤسسات الحكومية والخاصة. ولذلك يُقترح إدخال بعض التعديلات التي تُلزم أرباب العمل في الهيئات والمؤسسات المختلفة بتنفيذ التدخلات المنصوص عليها في الاستراتيجية.
- الصورة الذهنية والمفاهيم المغلوطة: الكثير من التحديات التي تواجه توفير الحماية الكاملة للمرأة مثل عمل المرأة والزواج المبكر وختان الإناث والحصول على حق الوصاية والميراث والنفقة والمتعة وغيرها من الحقوق يكمن منشؤها في المعتقدات والمفاهيم الدينية الخاطئة التي توارثها المجتمع، وعليه فُيقترح إضافة دور المؤسسات الدينية المتمثلة في الأزهر الشريف والكنيسة المصرية إلى التدخلات اللازمة في كافة محاور الاستراتيجية، بالإضافة إلى أن غياب الجانب الرقابي في الاستراتيجية يقلل من نسبة تنفيذ التدخلات وبالتالي الأهداف المرجوة وعليه فيقترح إضافة تعميم مكاتب رقابية في كافة المؤسسات الحكومية والخاصة لمراقبة التدخلات المنصوص عليها. على أن تتبع المكاتب لجهاز الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية لضمان تنفيذ التدخلات.
- البطء في اتخاذ القرارات التشريعية وسن القوانين: وقد أدى بطء اتخاذ القرارات التشريعية وسن بعض القوانين أو إدخال تعديلات على أخرى بشكل مباشر إلى تدني نسب نجاح بعض الأهداف ومثال على ذلك مشروع قانون زواج القاصرات الذي لم يخرج إلى حيز التنفيذ بعد.
- الافتقار لآليات المتابعة والتقييم: افتقرت الاستراتيجية إلى تحديد آلية المتابعة والقياس والتقييم والتقويم، ولذا يُقترح إضافتها، علاوة على تقسيم المدى الطويل (2030) إلى مدايات قصيرة ومتوسطة مُعلنة حتى يتسنى قياس مدى نجاح الاستراتيجية في تحقيق الأهداف والقيام بالتدخلات المناسبة حال الحاجة اليها.