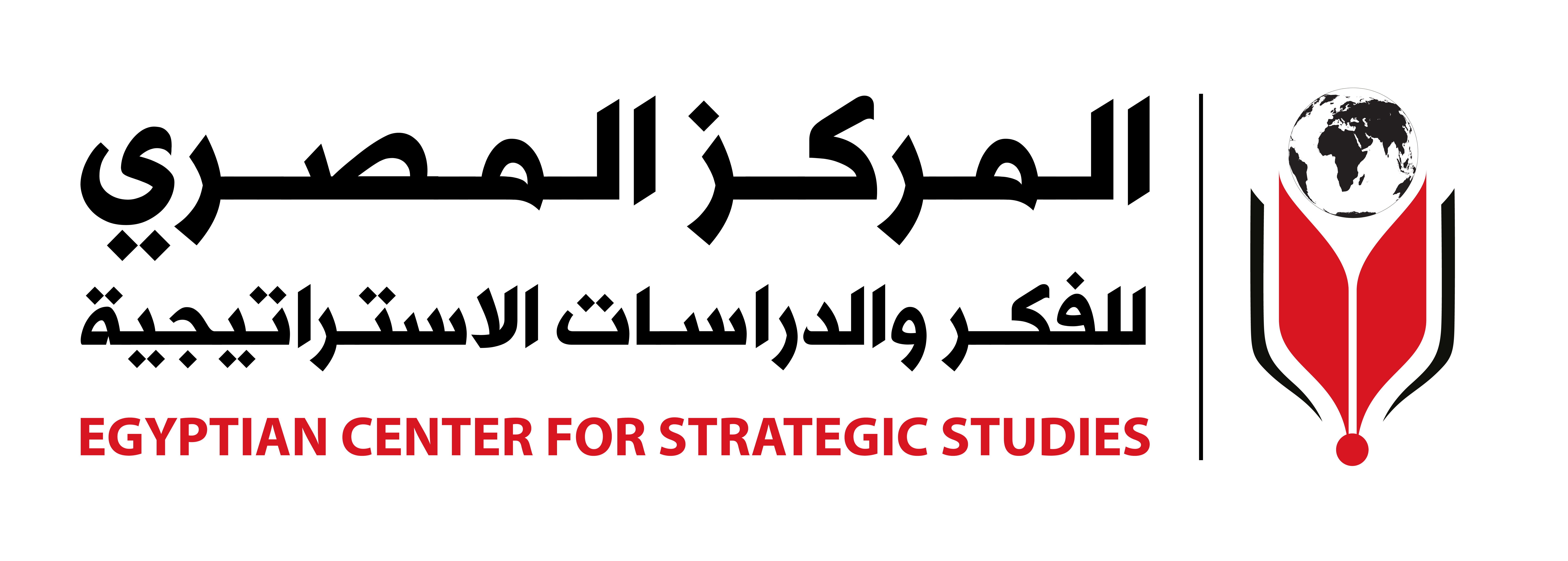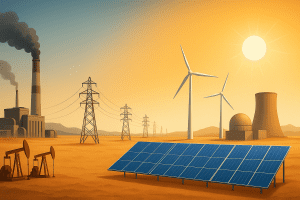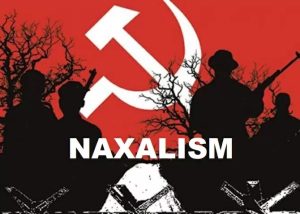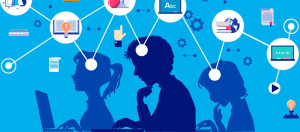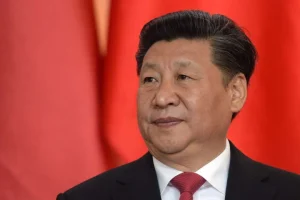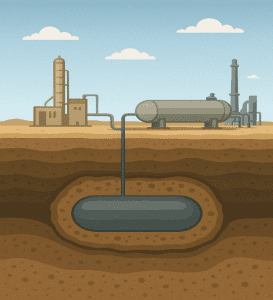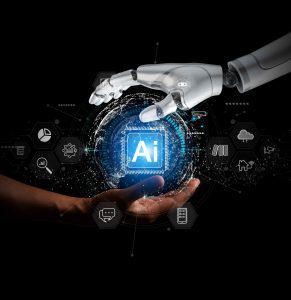بدأت مصر حرب الاستنزاف ضد إسرائيل على ثلاث مراحل في أعقاب نكسة 1967؛ أولها مرحلة الصمود (يونيو 1967-أغسطس 1968) التي هدفت إلى سرعة إعادة البناء ووضع الهيكل الدفاعي للضفة الغربية لقناة السويس، مما تطلب هدوء الجبهة حتى توضع خطة الدفاع موضع التنفيذ بما تتطلبه من أعمال كثيرة وبصفة خاصة أعمال التجهيز الهندسي المطلوبة. يليها مرحلة الدفاع النشط (سبتمبر 1968-فبراير 1969) والتي كان الغرض منها تنشيط الجبهة والاشتباك بالنيران مع القوات الإسرائيلية بغرض تقييد حركة قواتها في الخطوط الأمامية على الضفة الشرقية للقناة، وتكبيدها قدرًا من الخسائر في الأفراد والمعدات. يليها مرحلة التحدي والردع (مارس 1969-أغسطس 1970) من خلال عبور بعض القوات والإغارة على القوات الإسرائيلية لتكبيدها أكبر قدر من الخسائر في الأفراد والمعدات، وتهيئة الجيش المصري عمليًا ومعنويًا للمعركة المنتظرة، لتصل حرب الاستنزاف إلى ذروتها في أكتوبر 1973، حيث الهجوم المفاجئ واقتحام قناة السويس وتحرير الأرض واستعادة سيناء. خلال هذة الفترة الزمنية، نفذت كم هائل من الأعمال البطولية لأفراد القوات المسلحة البواسل، ومنها معركة “رأس العش”.
أولًا: خلفيات المعركة
إن “رأس العش” هي قرية صغيرة تقع جنوب بورسعيد بحوالي ١٤كم، سميت سلفًا البركة، وهي جزء ضيق يشبه الرأس، يحدها من الشرق والغرب قناة السويس. تبرز أهمية المعركة التي دارت فيها كونها بداية انحصار النكسة، وهي من تنفيذ مجموعة من ضباط وجنود الصاعقة، وهي إحدى معارك حرب 1967 في مرحلة الصمود، وأتت في أعقاب النكسة مباشرة، وإن تكللت بالنصر، مما أثر إيجابًا في نفوس الجنود.
دارت أحداث تلك المعركة يوم 1 يوليو 1967 بالقرب من ضاحية بور فؤاد، حين حاولت قوة من المدرعات الإسرائيلية احتلال تلك البقعة، فتصدت لها الصاعقة المصرية، مما أشعل شرارة أسفرت عن اندلاع حرب شاملة لاستنزاف العدو على ضفتي قناة السويس طيلة ثلاث سنوات.
ففي 5 يونيو 1967، تمكنت إسرائيل من احتلال سيناء عدا مدينة بورفؤاد الواقعة على الضفة الشرقية في مواجهة بورسعيد، وهي المنطقة الوحيدة في سيناء التي لم تحتلها إسرائيل في أثناء حرب يونيو، وإن ظنت إسرائيل أنها قد قضت تمامًا على مقاومة الجيش المصري، فراحت تعد العدة للتقدم قاصدة احتلال بورفؤاد وتهديد ميناء بورسعيد.
وفقًا للواء محمد عبد الغني الجمسي رئيس هيئة العمليات في أثناء حرب أكتوبر في مذكراته عن معركة “رأس العش” أنه في اليوم الأول الذي تولى فيه اللواء “أحمد إسماعيل علي” قيادة الجبهة في أول يوليو 1967، وفي الساعات الأولى من صباح 1 يوليو 1967، وبعد ثلاثة أسابيع من النكسة، تقدمت قوة مدرعة إسرائيلية على امتداد الضفة الشرقية لقناة السويس من القنطرة شرقًا في اتجاه الشمال بغرض الوصول إلى ضاحية بورفؤاد المواجهة لمدينة بورسعيد على الجانب الآخر للقناة، وعندما وصلت القوات الإسرائيلية إلى منطقة رأس العش جنوب بورفؤاد وجدت قوة مصرية محدودة من قوات الصاعقة المصرية قوامها ثلاثون مقاتلًا مزودين بالأسلحة الخفيفة، في حين تكونت القوة الإسرائيلية من 10 دبابات مدعمة بقوة مشاة ميكانيكية في عربات نصف مجنزرة، وحين هاجمت قوات الاحتلال قوة الصاعقة المصرية تصدت لها الأخيرة وتشبثت بمواقعها بصلابة وأمكنها تدمير ثلاث دبابات معادية.
فوجئت القوات الإسرائيلية بالمقاومة المسلحة المصرية التي أنزلت بها خسائر كبيرة؛ مما أجبرها على التراجع جنوبًا، إلى أن عاود الجيش الإسرائيلي الهجوم مرة أخرى، لكنه فشل في اقتحام الموقع بالمواجهة أو الالتفاف من الجنب، فدمرت بعض العربات نصف المجنزرة وزادت خسائره البشرية؛ مما اضطرت القوة الإسرائيلية للانسحاب. وبعد تلك الهزيمة، لم تحاول إسرائيل احتلال بورفؤاد، وظلت في أيدي القوات المصرية حتى قيام حرب أكتوبر 1973، فظلت مدينة بورسعيد وميناؤها بعيدين عن التهديد المباشر لإسرائيل.
ثانيًا: الصعوبات التي واجهتها القوات المصرية
دارت معركة رأس العش في ظروف شاقة بالغة الصعوبة بالنظر إلى اعتقاد إسرائيل في تراجع الروح المعنوية للجيش المصري بعد هزيمة 1967، كما أن سلاح الجو الإسرائيلي كان يمتلك السيادة الجوية المطلقة فوق المنطقة، أما عن القوة الضاربة (قوات المدرعات)، فقد خرجت القوات المدرعة الإسرائيلية من حرب يونيو 1967 بتشكيلاتها كاملة، وعوضت خسائرها من الدعم الغربي المتواصل في الوقت الذي خلت فيه منطقة بورسعيد وبورفؤاد من الوحدات المعاونة، سواء دبابات أو مدفعية ميدان أو مدفعية مضادة للطائرات أو وحدات مهندسين فيما عدا فصيلة الصاعقة (30 فردًا) على الضفة الشرقية.
وبالنظر إلى طبيعة أرض المعركة، فكانت عبارة عن لسان من الأرض موازٍ للقناة وسط المياه لا يزيد عرضه على 60-70 مترًا، على يمينه قناة السويس، وعلى يساره منطقة ملاحات يصعب الخوض فيها، وكان هذا اللسان هو الطريق الوحيد للوصول إلى بورفؤاد الذي يجب المرور فيه، لا سيما الجانب الأقرب للقناة باعتباره الجزء الأصلب من الأرض من ناحية، واتباع أسلوب قتالي يدفع الجنود الإسرائيليين إلى الالتفاف والتطويق لمحاصرة العدو بدلًا من المواجهة المباشرة من ناحية ثانية. وتحسبًا لذلك، وزع الأفراد على الموقع ووضع بعض الأفراد في المؤخرة بمدافع رشاشة خفيفة من الخلف، بجانب تمهيد الأرض عسكريًا.
حفر كل جندي لنفسه سواتر ترابية وما يسمى “حفرة برميلية”، وهي حفرة مستديرة قطرها نحو 80 سم بعمق يسمح للجندي بالنزول فيها بحيث لا يظهر منه إلا رأسه وأكتافه، ونظرًا لغياب أدوات الحفر أجري الحفر بشكل يدوي بسونكي البندقية والدبشك الحديدي بشكل مكشوف بالعين المجردة، ورغم ذلك أُرسلت طائرة استطلاع صغيرة (سوبر بكب) حلقت فوق مواقع قوات الصاعقة على ارتفاع شديد الانخفاض.
ولأن القوات المصرية لم تكن تملك التجهيزات المناسبة لأعمال القتال الليلية بالكفاءة النهارية نفسها، بدأت القوات الإسرائيلية في فتح نيرانها قبل المغرب بنحو 10 دقائق لاكتشاف المدى الذي ستصل إليه لتحديد موقع القوات المصرية بدقة قبل توجيه نيران دباباتها، بيد أن المقاتلين المصريين الذين لا يتعدون 30 مقاتلًا نجحوا في تعطيل القوات الإسرائيلية لمدة 23 ساعة إلى أن سكتت نيرانها قبل أن تستخدم القذائف الفسفورية لإضاءة أرض المعركة، وهي طلقات حارقة إن أصابت الجلد تسببت في حروق بالغة من الدرجة الأولى، وإن أصابت الثياب جعلت من المقاتل هدفًا سهلًا بعد أن تجعله مميزًا وواضحًا وسط الظلام. ورغم ذلك، عجزت القوات الإسرائيلية عن احتلال المدينة وانسحبت. وفي الساعة الثانية صباحًا، أجرى الرئيس الراحل “جمال عبد الناصر” اتصالًا تليفونيًا مباشرًا بالموقع؛ حيث أبلغ قائد القوة بترقية جميع المقاتلين في الضفة الشرقية للدرجة الأعلى ومنحهم نوط الشجاعة، وحثهم على ألا يسمحوا بمرور القوات الإسرائيلية إلى بورفؤاد على الإطلاق.
ثالثًا: النتائج الاستراتيجية للمعركة
الجدير بالذكر أن احتلال مدينة بورفؤاد سيحولها إلى قاعدة تمكن القوات الإسرائيلية من السيطرة على مدينة بورسعيد والقاعدة البحرية الموجودة بها لتصبح في مرمى نيران دباباته وهاوناته والأسلحة الصغيرة لعناصر المشاة المتمركزة في مدينة بورفؤاد ومن مسافات قريبة في حدود تتراوح بين 400-500 متر. ولذا، فإن معركة رأس العش مكنت قواتنا البحرية من الاحتفاظ بقاعدتها البحرية في بورسعيد طوال سنوات حرب الاستنزاف وفي أثناء حرب أكتوبر 1976؛ مما مهد الطريق لإغراق المدمرة الإسرائيلية إيلات. كما رفعت مخرجات المعركة من الروح المعنوية للقوات المصرية والشعب المصري في أعقاب النكسة، وحرمت إسرائيل من استكمال احتلال سيناء والضفة الشرقية لقناة السويس، واحتفظت مصر برأس جسر فيهما؛ مما لعب دورًا مهمًا في الهجوم على المواقع الإسرائيلية شمال القنطرة شرق إلى الكيلو 10.
ويمكن القول إن مدينتي بورفؤاد وبورسعيد تجنبا دمارًا شاملًا محققًا إن خضعتا للاحتلال؛ مما يعني عدة ملايين لإعادة الإعمار. كما قلصت معركة رأس العش من الخسائر البشرية المحتملة بين المدنيين والعسكريين نتيجة الاشتباكات وعمليات سلاح الجو الإسرائيلي المحتملة ضد مدينة بوسعيد. كما أن مصر تجنبت في إطار الخطط الهجومية لحرب أكتوبر 1973 تنفيذ عمليات هجومية لاسترداد مدينة بورفؤاد وتحريرها من القوات الإسرائيلية وكذا القتال داخل المدينة في معارك عنيفة وشرسة ترتفع تكلفتها في ظل ارتفاع تكلفة القتال في المدن.
ختامًا، جنبت معركة رأس العش مصر خسائر مهولة على الصعيدين المادي والبشري. فرغم التطور التكنولوجي والعسكري الهائل، فإن الفرد المقاتل لا يزال وسيظل هو العنصر الرئيس في أعمال القتال، فلا قيمة لأي معدة أو سلاح مهما كان تطورها دون الفرد المقاتل. ولقد استبسلت قوات الصاعقة المصرية في تلك المعركة؛ حتى أصبحت تدرس في كثير من المدارس العسكرية في العالم، بالنظر لفارق القوة والعتاد والعدد بين الطرفين، ورغم ذلك أجبرت القوات المصرية قوة تعادل ثلاثة أضعافها وهي مدججة بالمدرعات والأسلحة على الانسحاب. وعليه، أخذت القوات المسلحة على عاتقها مهمة تطوير الفرد المقاتل وإعادة تنظيم وحدات الصاعقة لتنفيذ أي مهام مستقبلًا سواء داخل مصر أو خارجها.
مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة
أكاديمية ناصر العسكرية العليا