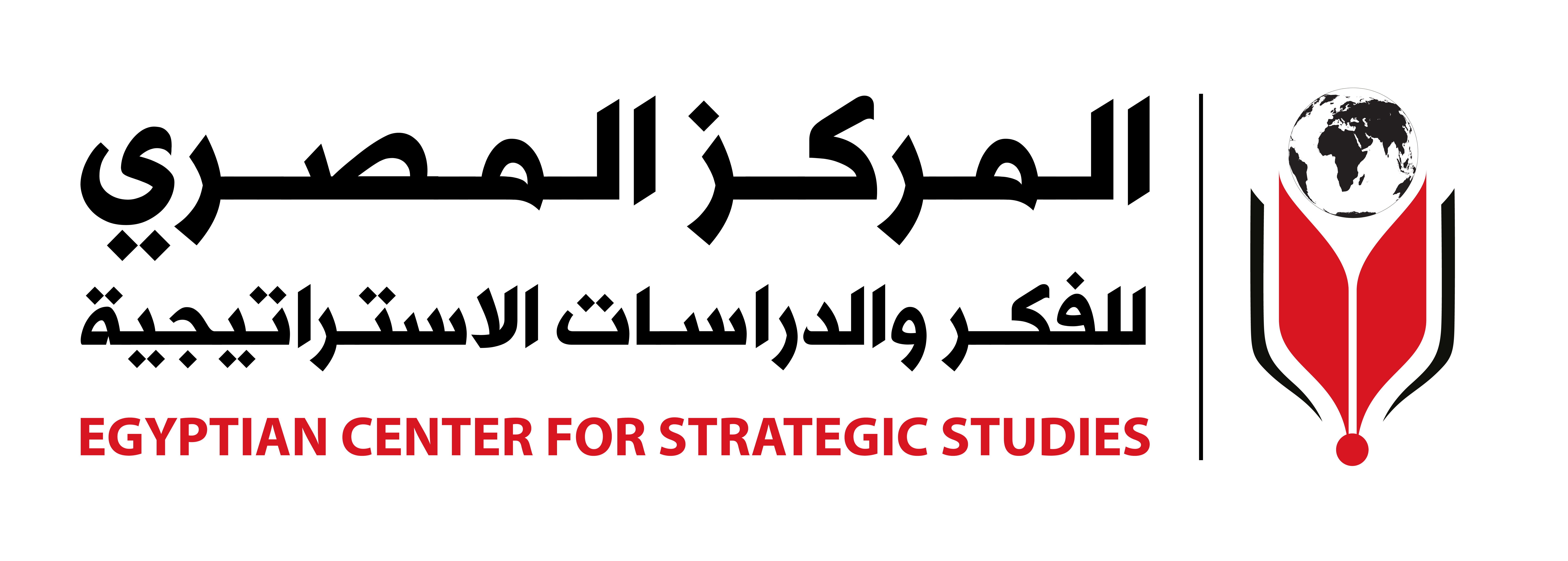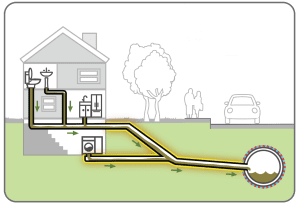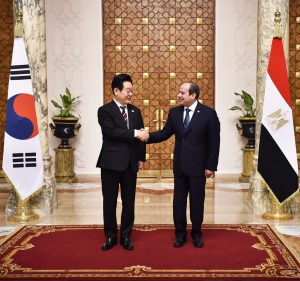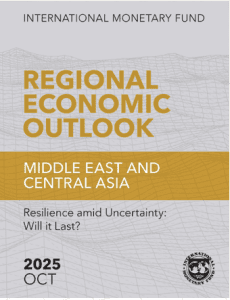لم يكن تفجر الصراع في إقليم تيجراي في نوفمبر 2020 أمرًا مفاجئًا، إذ سبقه تصاعد في موجات العنف متعددة الأبعاد لأكثر من خمس سنوات، كشفت عن العديد من مظاهر الوهن في بنية الدولة الإثيوبية وفي النموذج السياسي الذي تم تبنيه منذ مطلع التسعينيات والقائم على “الفيدرالية الإثنية” بما تضمنته من اختلالات متعددة على مستوى علاقات حكومة المركز بحكومات الأقاليم، وعلى مستوى علاقات حكومات الأقاليم ببعضها بعضًا. ومع استهلاك مختلف الأطراف في إثيوبيا الحلول السياسية للأزمات المتراكمة واحدًا تلو الآخر، تنامت فرص اللجوء للعنف على نحو ما تفجر بحدة في يوليو 2020 في إقليم أوروميا، قبل أن يتسبب إجراء حكومة إقليم تيجراي الانتخابات الإقليمية في سبتمبر من العام نفسه بإرادتها المنفردة وبالمخالفة لقرارات المجلس الفيدرالي في جعل إقليم تيجراي المرشح الأول لإطلاق التفاعلات الصراعية على نطاق واسع.
وعلى الرغم من أن التصور الأصلي لحرب تيجراي لدى الحكومة الفيدرالية في أديس أبابا كان قائمًا على شن عملية خاطفة لإسقاط حكومة الإقليم والسيطرة على كامل مساحته وتنصيب حكومة جديدة موالية في أضيق نطاق زمني ممكن، فقد حالت العديد من العوامل الجغرافية والسكانية والعسكرية دون تحقق هذا التصور على أرض الواقع. فالعملية الخاطفة التي أعلن رئيس الوزراء “آبي أحمد” اكتمالها قبل انقضاء أربعة أسابيع على إطلاقها، فشلت في فرض سيطرة كاملة على الإقليم الواقع في أقصى شمال البلاد.
وبالتوازي مع إجراء الانتخابات العامة في نهاية يونيو 2020، استعادت القوات التابعة لجبهة تحرير تيجراي السيطرة على مدينة ميكيلي عاصمة الإقليم وغالبية مدنه الرئيسية لتبدأ مرحلة جديدة من مراحل الصراع تبادلت فيها أطرافه مواقع الدفاع والهجوم. وبعد تمدد لقوات تيجراي في إقليمي العفر وأمهرا وأنباء عن التقدم صوب العاصمة الإثيوبية، انتهت موجة التمدد خارج حدود الإقليم بعد بلوغ القوى المتقاتلة مستوى متقدمًا من الاستنزاف، وتيقن الجميع من استحالة تحقيق أي طرف نصرًا حاسمًا في الصراع الذي دام أكثر من عام كامل.
وبجانب تعدد مراحلها، تعددت أبعاد الحرب في تيجراي بصورة لافتة. فبعيدًا عن جبهات الحرب الرئيسية تسببت حرب تيجراي في تفجر العديد من الأزمات الكامنة في مختلف الأقاليم الإثيوبية دون استثناء، والتي شهدت تصاعدًا غير مسبوق في حدة التفاعلات الصراعية فيها، سواء تلك التي كانت قوات الجيش الفيدرالي طرفًا فيها، أو التي وقعت بين قوات تابعة للحكومات الإقليمية وبعضها بعضًا.
فبالتوازي مع تفاعلات حرب تيجراي تنامى نشاط مجموعات مسلحة مناوئة للدولة في إقليمي أوروميا وبني شنقول-جوموز، كما وقعت اشتباكات عنيفة بين القوات التابعة لحكومة الإقليم الصومالي والقوات التابعة لحكومة إقليم العفر المجاور، هذا بالإضافة لمناوشات متعددة انخرطت فيها جماعة أمهرا مع عدد من الجماعات الصغيرة في الإقليم. ولم تكن الأبعاد الدولية أقل تعقيدًا من الأبعاد المحلية للصراع في إثيوبيا، فمنذ وقت مبكر تسبب الانخراط الإريتري المكثف في العمليات القتالية في إضفاء الطابع الإقليمي على الحرب في تيجراي على النحو الذي شمل كافة دول القرن الأفريقي دون استثناء، كما جاء الصراع على خلفية علاقات ثنائية متوترة أصلًا بين إثيوبيا والسودان، هذا بجانب البعد الدولي الذي اتضحت ملامحه تدريجيًا في ظل احتدام المنافسة الدولية على القرن الأفريقي.
على هذا الأساس، يُسلط كتاب “الصراع في إثيوبيا.. المشروع المأزوم وتداعياته الإقليمية”، الصادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية في يناير 2022، الضوء على الحرب في تيجراي منذ بدايتها المبكرة، ومختلف مراحل وأبعاد الصراع الذي شهدته إثيوبيا منذ خريف 2020.
بناءً على ما تقدم، يُناقش القسم الأول من الكتاب نشأة الصراع في إقليم تيجراي، وذلك من خلال استعراض جذور الصراع في إثيوبيا، والتفاعلات العديدة التي جرت بعد ذلك، وموقف الجماعات الإثنية من الصراع في تيجراي، والحسابات العسكرية والتحديات المستقبلية، واتجاهات الصراع في إقليم تيجراي وتداعياته الإقليمية، والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى خطاب الكراهية في إثيوبيا وتداعياته على تماسك الدولة.
فيما يتناول القسم الثاني المرحلة الثانية من الصراع، من خلال عدة موضوعات أبرزها: إثيوبيا بين استعادة التعايش وطموحات تقرير المصير، والتأجيل الثالث لإجراء الانتخابات في إثيوبيا، وأسباب انتقال الحرب من إقليم تيجراي لأمهرا، واستخدام سلاح الجوع في الحرب الأهلية الإثيوبية، وتطورات وتداعيات حرب “آبي أحمد” الثانية ضد تيجراي، وتنامي التطرف الديني في إثيوبيا، وتحالف القوميات وتوازناتها العسكرية المتغيرة في إثيوبيا، ومستقبل الحل السياسي في إثيوبيا بعد انتهاء الصراع، وفرص عودة تيجراي لحكم إثيوبيا.
وارتباطًا بالسابق، يستعرض القسم الثالث من الكتاب البعد الدولي للصراع في إثيوبيا من خلال توضيح دلالات ومحددات التقارب الإثيوبي-الإريتري، والدبلوماسية الإثيوبية في سياق مضطرب، والتناقضات السودانية-الإثيوبية المتنامية، وأزمة إغلاق السودان المعبر الحدودي مع إثيوبيا، والاستجابة الدولية للأزمة الإنسانية الناتجة عن الصراع في إثيوبيا، وتطور التعاطي الدولي والإقليمي مع الأزمة الإثيوبية، والعقوبات الأمريكية على إثيوبيا.
ثم ينتقل القسم الرابع من الكتاب إلى مناقشة الأبعاد المحلية للصراع في إثيوبيا، في ظل اتساع خريطة الصراعات الداخلية، ولا سيما ذات الطابع العرقي والإثني في إثيوبيا مثل الصراع بين الأمهرا والأورومو، والصراع في إقليم بني شنقول-جوموز، والصراع بين العيسى والعفر، والتمرد في إقليم أوروميا. بجانب ذلك، أزمة جماعة القيمانت في إقليم أمهرا. فضلًا عن مواقف قومية “العفر” من الصراع، والإقليم الصومالي (أوجادين)، وحسابات معادلة توازن القوى الداخلية، وإقليم القوميات والشعوب والأمم الجنوبية الإثيوبية باعتبارها فصلًا من فصول الانقسام، والانقسامات داخل قومية الأورومو حيال سياسات “آبي أحمد”.