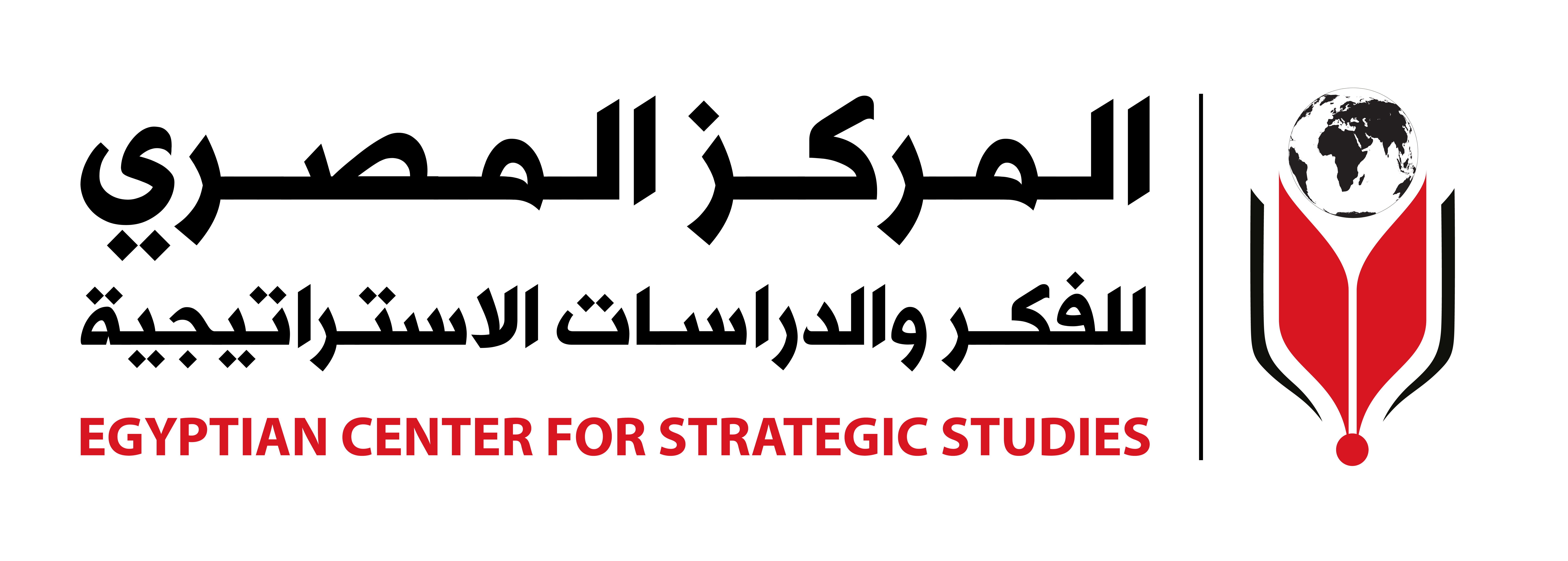منذ أن تولّى الرئيس السيسي حُكم البلاد وعد المصريين بأن مصر ستعود إلى مجدها، وأن الدولة العربية الأكبر في المنطقة ستعود للريادة. فخلال مؤتمر دعم الاقتصاد المصري في مارس 2015 أعلن الرئيس إطلاق مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ذلك المشروع الذي يعالج المشاكل الأزلية للعاصمة القديمة التي يتمثل معظمها في سوء التخطيط، وضعف البنية التحتية، وعدم جاهزيتها لتحقيق رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحويل مصر إلى دولة ذات اقتصاد رقمي قائم على المعرفة، اقتصاد يتوسع في الثورة الصناعية الرابعة وقادر على تقديم خدمات مميزة للمواطنين والمستثمرين. استُلهمت تلك الفكرة من التجارب العالمية الناجحة في إعادة تأسيس عواصمها، حيث إن مصر ليست هي الدولة الأولى التي تفكر في نقل العاصمة، فعلى مدار الخمسين عامًا الماضية فقط أقدمت 13 دولة على مثل تلك الخُطوة، وقد أثبتت تلك السياسة نجاحها في إعادة رسم البعد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للدول، وتحويلها إلى مدن جديدة يمكنها أن تقود العالم.
وإذ نحن في عامنا الحالي، وبعد ست سنوات من العمل الشاق، من المخطط أن يبدأ العاملون بالقطاع الحكومي في مصر (المرحلة الأولى منهم 55 ألف موظف يعملون في حوالي 30 وزارة) الانتقال إلى العاصمة الجديدة في أغسطس المقبل. تلك المدينه من المخطط أن تستوعب 6.5 ملايين مواطن سينعمون بالسكن في مدينة صُممت وفقًا لمدرسة التخطيط العمراني لما بعد الحداثة، حيث ينطبق عليها كل معايير الاستدامة التي عرفتها اللجنة العالمية للبيئة والتنمية (WECD)، إذ إنها تلبي احتياجات الجيل الحاضر دون المَساس بحق الأجيال القادمة، وتعزز حقوق المساءلة والإنصاف من خلال توفيرها السكن والخدمات بنفس معايير الجودة. وهي تضمن للمُشاة حقهم من خلال توفير شبكة طرق للمُشاة تربط أنحاء المدينة، ومدينه مُتصلة من خلال شبكة واسعة من الاتصالات والنقل، هذا فضلًا عن كونها مدينة ذكية تقدم الخدمات لجميع قاطنيها بالاعتماد على شبكة المعلومات وتجمع بيانات من خلال أجهزة الاستشعار عن بعد لتضمن تقديم تجربة عيش مميزة لقاطنيها.
تم اختيار موقع المدينة بعناية لتتوسط القاهرة (على بعد 45 كيلو من العاصمة الحالية) ومدينه السويس التي تحتضن أهم ممر ملاحي في العالم يعبر به 10 -12% من حجم التجارة العالمية، بعد أن استمر العمل على قدم وساق لبنائها حتى في ظل الظروف التي مر بها العالم خلال جائحة كورونا، كانت الآلات تعمل ليلًا ونهارًا لتحقيق الحُلم المصري في بناء مدينة جديدة تليق بمكانة مصر. أما عن توقيت البدء في التنفيذ فقد كان مثاليًا، حيث كانت الدولة المصرية تعاني الآثار السلبية التي خلفتها ثورة 2011 والتي رافقتها حالة عدم الاستقرار السياسي، وانهيار تام في مؤسسات الدولة بشكل أثر على إنتاجية البلاد، تسبب توقف الإنتاج وعدم الاستقرار السياسي في انتكاسة كبيرة للاقتصاد، ودعا ذلك الدولة إلى التدخل بشكل عاجل لإعادة إحياء الاقتصاد، حيث إن القطاع العقاري والتشييد والبناء هي القطاعات الأسرع في خلق فرص العمل كونها توفر مساحات تجارية للشركات والمكاتب، ومن ثم تعزز تأسيس شركات جديدة تساهم في دفع النمو الاقتصادي. أمر آخر يعزز من مكانة القطاع العقاري هو حجم مساهمته الكبير في الاقتصاد، إذ يساهم القطاع العقاري بحوالي 15.2% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوظف عدد 3.4 ملايين عامل (13% من اجمالي المشتغلين في مصر)، ويتمتع القطاع بروابط أمامية وخلفية مع أكثر من 100 صناعة أخرى. لكن تلك ليست الأسباب الوحيدة، حيث إن مصر دولة كبيرة ذات نمو سكاني مرتفع يترتب عليه ما يقرب من مليون زيجة سنويًا يحتاجون لحوالي مليون وحدة سكنية، ويعتبر حجم العرض بالقطاع أقل من حجم الطلب، وهو ما يعني أن القطاع في حالة عجز دائم تقريبًا.
اقتصاد أقوى
ساهمت مشروعات الدولة المختلفة، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النمو، إذ حقق الاقتصاد المصري معدل نمو 4.4% في عام 2015، 4.3 في عام 2016، 4.2% في عام 2017، 5.3 في عام 2018، 5.6% في عام 2019. ففي تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في مارس 2020 حول الأثر المتوقع لأزمه كورونا على الاقتصاد العالمي، أشار إلى احتمال تباطؤ الاقتصاد العالمي بنسبة 3%، في الوقت الذي ستستطيع فيه مصر تحقيق نمو اقتصادي بحوالي 3.6% (حققت مصر نموًا اقتصاديًا بنسبة 2.7%)، لتؤكد على مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات. ليس ذلك فقط، حيث ساهمت تلك المشروعات في خفض معدل البطالة في مصر من 13.15% في عام 2013 إلى 10.13% في عام 2020، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال اعتبار العاملين بالقطاعات بالدولة عمالة مؤقتة، حيث إن مصر بتركيبتها الديمغرافية التي يشكل سن الشباب معظم سكانها، وبمعدل نمو سكاني يقترب من 2%، وثقافة ترتبط بشكل كبير برغبة الشباب في الإقبال على الزواج وتملك المنازل، واقتصاد متنامٍ أثبت نجاحه بإشادة من العديد من مؤسسات التمويل العالمية؛ فإن ذلك يعني وجود استدامة في الطلب على الوحدات العقارية، سواء لغرض السكن أو للأغراض التجارية (مكاتب إدارية، وتجارية). أمر آخر يمكن الاستدلال به للتأكيد على حاجة الاقتصاد المصري للاستثمارات في البنية التحتية وهي توقعات البنية التحتية العالمية “Global Infrastructure Outlook” الذي أشار إلى احتياج مصر لاستثمارات بقيمة 675 مليار دولار خلال الفترة بين 2016/2040.
شراكة تعزز التنمية
أما عن مساهمة كل من القطاع العام والقطاع الخاص بتلك المشروعات، فوفقًا لتقرير بحثي تم إعداده من جانب (Oxford Business Group) بعنوان مصر 2020، فقد شكلت استثمارات القطاع الخاص في مجال التشييد والبناء للعام المالي 2018/2019 نسبة 90.3% من مساهمة قطاع التشييد والبناء في الناتج المحلي، إذ بلغت الاستثمارات 289 مليار جنيه، مقابل 31.1 مليار جنيه استثمارات القطاع العام (9.7% من إجمالي الاستثمارات). هذا فضلًا عن أن الدولة المصرية دائمًا ما كانت تدرك أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، كونها السبيل الوحيد لتحقيق استراتيحية التنمية الاقتصادية طويلة المدى بالبلاد، فقد تأسست الوحدة المركزية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة المالية في عام 2006 بهدف توفير تمويل مشروعات البنية التحتية، وتقليل حاجة الحكومة إلى الاقتراض السيادي، وتخفيف العبء عن ميزانية الدولة، وأكد الرئيس السيسي على ذلك التوجه مرة أخرى من خلال إعلانه أن الحكومة تسعى لإقامة شراكات مع القطاع الخاص في جميع مشروعات البنية التحتية بالبلاد. ولذا فقد تعاونت هيئة المجتمعات العمرانية مع القطاع الخاص في تطوير الأراضي بنظام الشراكة، وتم إطلاق المرحلة الأولى منها في 2015 لتطوير 5 قطع أراضٍ بمساحة قدرها 2034 هكتارًا، بينما شهدت المرحلة الثانية التي تم توقيعها في 2018 تخصيص ست قطع أراضٍ تغطي 959 هكتارًا. أما المرحلة الثالثه فهي تشمل خطة تطوير 20 قطعة أرض في تسع مدن جديدة، تغطي مساحة إجمالية قدرها 4047 هكتارًا. وتعاونت الدولة أيضًا مع القطاع الخاص في مجال التعليم، ولذا فقد تم إطلاق مبادرة لإنشاء وتشغيل 24 مدرسة بإجمالي 910 فصول دراسية بتكلفة متوقعة 40 مليون دولار أمريكي في عام 2019 باستخدام نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
الدين العام: مسار هبوطي.
يشير البعض إلى أن بناء العاصمة الإدارية الجديدة تسبب في زيادة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وحقيقة الأمر أن ذلك غير صحيح، حيث إن إجمالي الدين العام (داخلي وخارجي) إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفض في عام 2015 إلى 85% مقابل 90.5% في العام السابق له، لكنه ما لبث إلا أن ارتفع في السنوات 2016 و2017 ليصل إلى 103% في عام 2017، وهو لسبب غير مرتبط بزيادة الاستدانة المصرية، حيث إن ذلك الارتفاع بالأساس ناجم عن قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري الذي تم ضمن برنامج إصلاح اقتصادي، ومن ثم فهو بالأساس نتيجة لثبات بسط المعادلة (الدين العام الذي يتضمن جزءًا بالدولار لم تنخفض قيمته) مع انخفاض قيمة المقام (إجمالي الناتج المحلي الإجمالي مقومًا بالدولار)، وحتى ذلك الارتفاع الناجم عن انخفاض قيمة الناتج المحلي الإجمالي نتيجة لقرار تحرير سعر الصرف قد تلاشى في السنوات التالية، حيث انخفض الدين العام في عام 2018 إلى 92.5% وتابع الانخفاض في عام 2019 وصولًا إلى 84.2%، وهي السنوات التي شهدت تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة. وعاد الدين العام للارتفاع مرة أخرى في عام 2020 نتيجة للاستدانة الحكومية لمواجهه جائحة كورونا، وقد حدث ذلك في معظم دول العالم، ويعتبر ذلك الوضع طارئًا سيتلاشى مستقبلًا بانتهاء جائحة كورونا. حيث شهد الدين العام المصري ارتفاعًا خلال عامي جائحة كورونا (2020، 2021) بنسب (6% و2.7% على التوالي) وهي نسب جيدة مقارنة بدول أخرى مثل (المملكة المتحدة، وأمريكا، واليابان).
المصدر 1: مصدر البيانات، قاعدة بيانات Statista
تكامل مؤسسي
يدعي البعض أن القائم على تنفيذ تلك المشروعات هي القوات المسلحة، ولكن بالتفكير المنطقي: هل يعقل أن تكون القوات المسلحة قادرة على تنفيذ مدينة جديدة مترامية الأطراف على مساحة 170 فدانًا، أي حوالي 5.6 كم مربع؟! وهي ليست المدينة الوحيدة التي نفذتها مصر بعد ثورة يونيو، فحجم الأعمال التي تم تنفيذها في هذا القطاع هائلة لا يمكن لمؤسسة وحيدة في الدولة القيام بذلك العمل منفردة، ومن ثم فإن جميع العاملين على تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة هي شركات القطاع الخاص المصرية التي تقدمت لتنفيذ تلك المشروعات. من جانب آخر، يرى البعض أن القوات المسلحة المصرية تلعب دور المشرف على تنفيذ بعض المشروعات، وهو أمر حقيقي ومُعلن، فإذا كان لديك الجيش الأكبر في المنطقة بقوام يقترب من نصف مليون فرد، ومصر في حالة سلام مع جميع الدول المجاورة (باستثناء حربها ضد الإرهاب)، وسياستها الخارجية سياسة شريفة محبة لجميع دول المنطقة وداعمة لتنميتها؛ فإن توظيف هؤلاء الأفراد المُدربين وعلى درجة عالية من المهارات الإدارية والقيادية يعد استغلالًا أمثل للموارد المتاحة، وهو حل أثبت أنه الأمثل للنهوض بالدول التي تعاني أجهزتها الإدارية من نقص كبير في الخبرات الإدارية والمهارات الفنية التي تتعلق بالإشراف لحين بناء الجهاز الإداري بالدولة بشكل فعال، ومن ثمّ فإن النموذج المصري في الاستعانة بإحدى مؤسساته هو نموذج يُدرس في العديد من الدول عالميًا خاصة النامية منها. ومن الجدير بالذكر أن مصر ليست الدولة الوحيدة التي انتهجت سياسة التكامل المؤسسي، حيث انتهجت العديد من دول العالم نفس النهج في الدفع بأجهزة الدولة المختلفة لمعاونة بعضها بعضًا لزيادة قدرة الدولة على عبور الأزمات، حيث رأينا كيف كان دور الجيش والشرطة المحوري عالميًا في مكافحة وباء فيروس كورونا من خلال إجراء عملية تطهير كامل للبلاد، ونقل المواد الطبية والمعدات بين المقاطعات، وبناء مستشفيات عزل عاجلة لاستيعاب المصابين، والدخول في عمليات تصنيع لأجهزة التنفس الصناعي. تكرر ذلك المشهد في دول مختلفة، منها فرنسا والصين وكوريا الجنوبية، وقد كان ذلك محل تقدير كبير من شعوبهم بأن لديهم جيشًا يحمي البلاد ليس فقط من الحروب فهو يحميها من الكوارث الطبيعية والأزمات أيضًا، ومن ثم فإن تعاون مؤسسات الدولة في إدارة الأزمات التي تمر بالبلاد هو من سمات الإدارة العامة الحديثة، التي تعزز مفهوم تكامل مؤسسات الدولة نحو تحقيق هدف واحد في أوقات الأزمات.
أمرٌ آخر يمكن النظر إليه وهو أن جيوش الدول قد تمثل عبئًا على دولها في حال عدم استغلالها الاستغلال الأمثل، حيث إن وجود طاقة بشرية مكونة من 500 ألف فرد يحتاجون إلى طعام وملابس ووقود، هذا بالإضافة إلى المعدات، تلك الاحتياجات المستدامة قد تشكل ضغطًا كبيرًا على قدرة الدول على الوفاء بها، ليس فقط في أوقات الحروب لكن في أوقات السلم أيضًا، حيث إنه طلب ثابت قد يتسبب في حدوث اهتزازات كبيرة في أسعار المنتجات في حال عدم قدرة المؤسسة على الوفاء باحتياجاتها ولو جزئيًا، لذلك نرى دخول الجيش في بعض الصناعات الحيوية التي لها علاقة كبيرة بأمن الجيش والوفاء باحتياجاته الأساسية أو بالأمن القومي المصري، وهو يعد من الواجبات الأساسية لتلك المؤسسة التي عقيدتها الأولى هي الدفاع عن الوطن، خاصة وأن مصر دولة كبيرة بتعداد سكاني هائل لا يمكن لأي جهة أو مؤسسة أن تفي بكامل احتياجاتها. ومن ثم فإن معظم المشروعات التي يساهم فيها الجيش في الاقتصاد تتركز في المواد الغذائية التي هي بالأساس للوفاء باحتياجات القوات المسلحة أولًا، ثم طرح الفائض في السوق لمساعدة باقي قطاعات الدولة على الوفاء بالعجز الكبير في الإنتاج. وقد تم الإعلان عن طرح عدد من الشركات المملوكة للشركة الوطنية (الوطنية للوقود، وصافي لمياه الشرب) بسوق الأوراق المالية المصري، أو البيع لمستثمر استراتيجي، ليؤكد الجيش على مبدأ أساسي وهو أن تلك الشركات هدفها الأول هو المساهمة في بناء الاقتصاد المصري، وتقليص الفجوة بين الطلب والعرض وليس التحكم في الاقتصاد.
نموذج يُقتدى به
خلاصة القول، إن ثورة الثلاثين من يونيو كانت بداية جديدة أعادت فيها مصر بناء المؤسسات الدستورية للدولة، وتبنت برنامج إصلاح اقتصادي شامل، ترتب عليه أن تحسنت المؤشرات الاقتصادية، ووضعت الاقتصاد المصري في مصاف الدول الأقل تأثرًا بجائحة كورونا عالميًا في عام 2020، واستطاع الاقتصاد المصري النمو بمعدل 2.7% في وقت كان فيه الاقتصاد العالمي ينكمش بنسبة 3%. ولعل أبرز مظاهر هذا التحول هو ما تنطق به المؤشرات الاقتصادية الكُلية، حيث ارتفعت مُعدلات النمو الاقتصادي خلال النصف الأول من عام 2019 إلى 5.6% من مُعدلات 5.3% خلال كامل العام 2018، مُقارنة بـ2.9% خلال عام 2014، وهي معدلات تعتبر الأعلى منذ عام 2008. وشهدت مُعدلات التضخم تراجعًا ملحوظًا، حيث استطاع البنك المركزي الحفاظ على معدل التضخم عند مستوى 5%، وهي نسبة أقل من مستهدف البنك المركزي (7% +- 2%)، بعد أن كانت قد بلغت أعلى مُعدلاتها على الإطلاق خلال عام 2017 بما يُجاوز 23% مدفوعة بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار. أما عن مُعدلات البطالة التي كانت قد بلغت في عام 2014 أعلى مُعدلاتها مُنذ عام 1990 عند مستوى 13.4%، فانخفضت كذلك بأسرع وتيرة خلال الأعوام التالية لتصل إلى مستوى 8.6% خلال كامل 2019، ويرجع الفضل في ذلك إلى ما تبنته الدولة من مشاريع قومية كبيرة في قطاعي التشييد والنقل والمواصلات، إذ نفذت الدولة برنامجًا تريليونيًا لتشييد مجموعة من المُدن الجديدة أهمها العاصمة الإدارية ومدينة العلمين، وهي مدن من فئة الجيل الرابع، وساهمت تلك المشروعات في خدمة الأهداف التنموية للبلاد لتخطو خطوة أخرى نحو هدف أن تصبح مصر مركزًا ماليًا إقليميًا يربط بين إفريقيا والعالم الخارجي.
من جانب آخر، تشير جميع مؤشرات المالية العامة إلى تحسن كبير في أدائها، حيث استطاعت الموازنة العامة للدولة تحقيق فائض أولي لثلاثة أعوام مُتتالية بداية من العام المالي 2017/2018، حيث انخفضت نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي، وارتفعت قدرة مصر على الوفاء بمتطلبات الدين في ضوء ارتفاع الاحتياطي النقدي من العُملات الأجنبية، وارتفع التصنيف الائتماني لمصر، وتحولت نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية للاقتصاد المصري إلى نظرة إيجابية. نجحت الموازنة فقد حققت فائضًا أوليًا لأول مرة مُنذ تسعينيات القرن الماضي في العام 2017/2018 بإجمالي 4.8 مليارات جنيه، وحافظت على هذا الأداء في العامين التاليين لتُحقق 103 مليارات في 2018/2019 و123.9 مليار جنيه في العام 2019/2020.
هذه المؤشرات السابقة كانت ستبقى مُجرد أرقام بلا معنى إذا كان الاقتصاد المصري قد تعرض لهزة كُبرى تحت تأثير صدمة كورونا، لكن العكس تمامًا هو ما حدث، إذ تلقاها واقفًا على قدميه مُستندًا إلى أساسات صلبة، جعلت مصر خالية من مشاهد تقاطر المواطنين على المُجمعات الاستهلاكية للحصول على المُنتجات الغذائية أو المخابز بسبب عدم توافر الخبز، إذ نجحت الحكومة في توفير ذلك مُنذ بداية الأزمة على عكس ما حدث في بعض البلدان الأكثر تقدمًا، ولعل ذلك يُشير إلى النجاح في إعادة صياغة الاقتصاد المصري بكامله وتصحيح هياكله ووضعه على الطريق الصحيح للنمو، ليكون أكثر قدرة على التعامل مع الأزمات واستغلال الفرص. هذا النجاح هو حقيقة ما يُفسر التوقعات الكبيرة للاقتصاد المصري قبل الجائحة بالوصول للمرتبة العاشرة عالميًا في عام 2035 من حيث الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لعدد من المؤسسات الاقتصادية، وقدرة الاقتصاد على الصمود في ظل الجائحة وتحقيق نمو إيجابي في وقت عانى فيه الاقتصاد العالمي من انكماشة، تلك الخطوات والنتائج تعزز من النظرة الإيجابية للاقتصاد المصري لقدرته على أن يصبح ضمن الاقتصادات العشرين الكبرى خلال العقد الحالي.