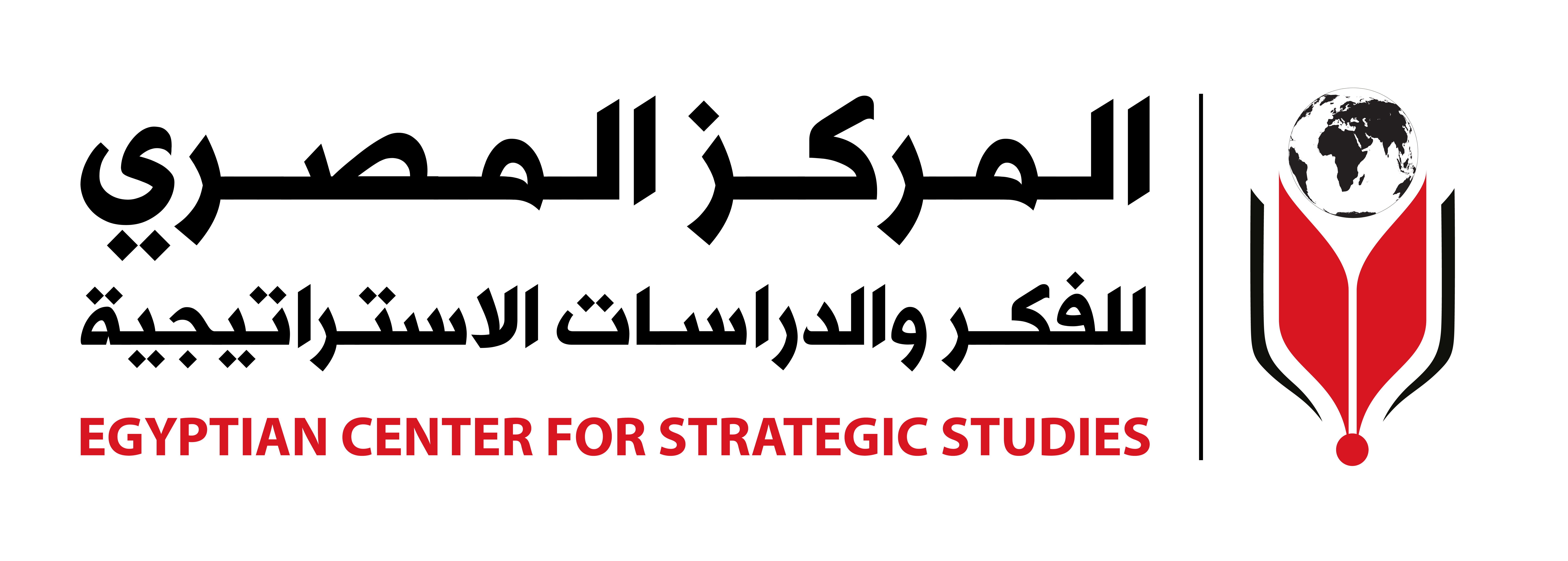عَقد المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، يوم السبت المُوافق 5 سبتمبر 2020، حلقة نقاشية بعنوان: “ما بعد انقلاب مالي: إلى أين تتجه الأزمات المتفاقمة في الساحل الإفريقي“، عبر تقنية “فيديو كونفرانس”، بمُشاركة كلٍّ من الدكتور “خالد عكاشة” مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والدكتور “أحمد حمد” رئيس الجامعة البريطانية في مصر، والدكتورة “نهى بكر” عضو الهيئة الاستشارية بالمركز، والسفير “علي الحفني” مدير مركز مصر إفريقيا بالجامعة البريطانية في مصر، والدكتور “أحمد أمل” رئيس وحدة الدراسات الإفريقية بالمركز، والدكتور “خالد حنفي” مساعد تحرير مجلة “السياسة الدولية”، والدكتورة “رانيا خفاجة” مدرس العلوم السياسية بمعهد البحوث الإفريقية، والدكتورة “مروى ممدوح سالم” خبيرة في الشئون الإفريقية.

أبعاد واتجاهات: أزمات الداخل في الساحل الإفريقي
تحدث الدكتور “أحمد أمل” عن أبعاد أزمات الداخل في الساحل الإفريقي من خلال تسليط الضوء بداية على الوضع الداخلي في مالي، بالتركيز على: وضع المؤسسة العسكرية في مالي، وتآكل التجربة الديمقراطية في دول الساحل الإفريقي، والارتباط بين الظاهرة الإرهابية والصراعات الإثنية، والعوامل غير السياسية والأمنية، واتجاهات مُستقبلية للإقليم، على النحو التالي:
– المؤسسة العسكرية في مالي: أشار دكتور أحمد أمل إلى ما قام به عدد من الجنود في الجيش المالي، في منتصف أغسطس 2020، من إطاحة برئيس الجمهورية وعدد من الوزراء بسبب سخط مُتراكم خلال السنوات الماضية، حيث بدأت الحركات الإرهابية في مالي استهداف مُعسكرات الجيش والقوات الأمنية المُنخرطة في مُكافحة الإرهاب كهدف رئيسي، خلال الفترة ما بين ربيع 2019 حتى الوقت الحالي، وقد خلق هذا الوضع حالة من السخط داخل الجيش المالي، بالإضافة إلى تعثّر محاولات تقديم الدعم المالي واللوجيستي من جانب الشركاء الإقليميين والدوليين، وفي النهاية اتُّهم الرئيس “كيتا” بأنه كان يتبنى سياسات ضعيفة حيال مُكافحة الإرهاب، ولم يقدم الدعم الكافي للقوات الأمنية.
– تآكل التجربة الديمقراطية في دول الساحل الإفريقي: كانت دول الساحل الإفريقي من أوائل الدول التي انتهجت التعددية الحزبية في مطلع التسعينيات، وأقامت تجارب ديمقراطية شهدت بعض النجاح، ومنها تجربة مالي، ولكن ما حدث من سياسات تبناها الرئيس “كيتا” خلال الفترة 2013-2020، بما فيها الفساد وعرقلة الإصلاح الدستوري؛ ساهم بشكل كبير في إضعاف التجربة الديمقراطية في مالي.
– الارتباط بين ظاهرة الإرهاب والصراعات الإثنية: يشهد الساحل تنامي الارتباطات بين بعض التنظيمات الإرهابية والجماعات الإثنية. وفي المقابل، يشهد إقليم الساحل الإفريقي تشكيل جماعات الدفاع الذاتية للدفاع عن الجماعات التي تتعرض بشكل مُتكرر للهجمات الإرهابية، وهو ما ترتب عليه انقسام كبير في النسيج الاجتماعي في مالي.
– العوامل غير السياسية والأمنية: تتضمن العوامل غير السياسية التأثيرات المُناخية التي أدت إلى جفاف بحيرة تشاد، وهو الأمر الذي تسبب في انتشار الفقر في الإقليم، وتزايد معدلات النزوح، حيث شكلت الجماعات النازحة وقودًا مهمًّا للتنظيمات الإرهابية من خلال تجنيد المقاتلين، هذا بالإضافة إلى الخلل في التركيب السكاني بدول الساحل، وهي الدول الأكثر شبابًا على مستوى العالم، حيث تجاوزت نسبة الأفراد الذين لم تتجاوز أعمارهم الخامسة والعشرين 50% من سكانها.
– اتجاهات مُستقبلية للإقليم: من غير المتوقع أن تشهد الفترة القادمة حلولًا حاسمة للأزمات المزمنة، إلا أنه من المرجّح تمرير هذه الخطوة بشكل مشروط من خلال دمج الإدارة المدنية بشكل واضح في العملية الانتقالية، وتسليم السلطة إلى حكومة مدنية مُنتخبة في أقرب وقت ممكن، فضلًا عن احتمالية الانفتاح على شكل من أشكال الحوار المباشر وغير المباشر بوساطة دولية أو محلية، مع التنظيمات الإرهابية.
عسكرة التنافس الإقليمي والدولي في الساحل الإفريقي
تناولت دكتورة رانيا خفاجة، تقييمًا لجوانب الضعف والقوة لعسكرة التنافس الدولي والإقليمي في الساحل الإفريقي، من خلال مجموعة من العناصر؛ والتي حاولت من خلالها الإجابة عن تساؤل: لماذا تتنافس القوى الإقليمية والدولية حول إقليم الساحل؟ بالإضافة إلى قراءة في الأهمية الاستراتيجية، ومظاهر عسكرة التنافس، والإشكاليات والمخاطر المُرتبطة بعسكرة التنافس في إقليم الساحل.
1- الأهمية الاستراتيجية لإقليم الساحل الإفريقي:
تأتي الأهمية الاستراتيجية لأي إقليم من خلال منظورين؛ هما:
المنظور الأول (الفرص): التي تعني ما يزخر به هذا الإقليم من ثروات طبيعية ومعدنية (الذهب، النفط، الغاز، اليورانيوم)، والتي تسعى القوى الغربية والإقليمية إلى السيطرة عليها، ويوفر هذا الإقليم فرصة للتوسع في صادرات السلاح لبعض الفواعل، وهو عنصر مهم لروسيا على وجه التحديد.
المنظور الثاني (المخاطر): يحتوي الإقليم على أكثر الدول ضعفًا وهشاشة ما يُمثل خطرًا على الأمن الإقليمي والدولي. وفي مؤشر الدول الهشة تأتي معظم دول الإقليم في المقدمة، حيث تعاني من مشاكل الحوكمة والفساد، وضعف قدرة الدولة على احتواء العنف، وعدم قدرتها على السيطرة على مشكلاتها، التي تنعكس بالضرورة على الأمن الإقليمي والدولي.
2- مظاهر عسكرة التنافس في إقليم الساحل:
يُقصد بالعسكرة اللجوء إلى شكلٍ من أشكال التدخل العسكري كآلية وحيدة لحل إشكاليات الساحل الإفريقي، ومظاهر هذه العسكرة تتمثل في فواعل مختلفة تتحرك وفقًا للمصالح، كالتالي:
– فرنسا: ترتبط بمعظم دول الساحل الإفريقي بحكم الماضي والخبرة الاستعمارية، ولها قواعد وقوات واتفاقيات تعاون عسكرية في الإقليم، وكانت من أولى الدول التي تدخلت عسكريًّا في هذا الإقليم بعملية سيرفال عام 2013 عقب أزمة مالي، ثم سعت لتأمين غطاء دولي للتدخل من خلال تشجيع الأمم المتحدة لعملية حفظ السلام في مالي، ثم عمليات التدخل الفرنسي مثل عملية برخان عام 2014، ثم عملية تاكوبا عام 2020.
– الولايات المتحدة الأمريكية: متواجدة من خلال القيادة الإفريقية المعروفة بأفريكوم، وشركات الأمن الخاصة التي تساعد الولايات المتحدة الأمريكية، ويشكل الوجود العسكري الأمريكي دعمًا لوجستيًّا لفرنسا في عمليات الرصد والتتبع.
– روسيا: تستخدم حزمة من الأدوات؛ منها: اتفاقيات التعاون الأمني والعسكري، حيث أبرمت نحو 19 اتفاقية تعاون عسكري مع الدول الإفريقية، ثم امتدت بعد ذلك إلى دول الساحل، وتستخدم أيضًا شركات الأمن الخاصة في مالي وليبيا.
– الاتحاد الأوروبي: تأتي مساهمة الاتحاد الأوروبي فيما يُعرف بالسياسة الأمنية والدفاعية المشتركة من خلال بعثات تدريب في مالي منذ عام 2014، وبعثات بناء القدرات في النيجر منذ عام 2012، والتي تركز جميعها على الجانب الأمني.
– الصين: مشاركتها تتمثل في بعثة الأمم المتحدة في مالي.
– تركيا: تسعى إلى التغلغل في القارة الإفريقية من خلال العديد من الأدوات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، حيث عقدت اتفاقيات عسكرية مع معظم دول الساحل الإفريقي، أحدثها اتفاق تعاون عسكري في النيجر في يوليو 2010.
– الإشكاليات والمخاطر المُرتبطة بعسكرة التنافس في إقليم الساحل: والتي من أبرزها: التركيز على مُكافحة الجماعات الإرهابية دون التوصل إلى سلام شامل معها، والتركيز على الجانب الأمني فقط، وعدم التوصل إلى معالجة جذور وأسباب المشكلات في الساحل الإفريقي.
تشابكات جماعات الإرهاب وتأثيرها في الساحل الإفريقي
أوضح السفير “علي الحفني” خطورة ظاهرة الإرهاب، وتزايد عدد المنظمات الإرهابية في هذه المنطقة، وتضخم عدد العناصر المُنخرطة في النشاط الإرهابي، وتعقد الظاهرة باللجوء إلى المرتزقة، واستمرار عمليات التمويل، وتقاطع النشاط الإرهابي مع الجريمة المُنظمة، والتجارة غير المشروعة للسلاح، والاتجار في المخدرات والبشر، وتزايد أعداد الضحايا والمصابين، ونزوح أعداد كبيرة من البشر، وارتباط أزمات المنطقة بتفشي ظاهرة الفساد، وهو الأمر الذي سَلط انقلاب مالي في 18 أغسطس 2020 الضوء عليه وعلى واقع الأزمات المُتفاقمة بالساحل الإفريقي.
وفي هذا السياق، أشار “حفني” إلى تواجد تنظيم “داعش” في جنوب ليبيا، ومحاولة تقربه من تنظيمات أخرى مثل تنظيم “بوكو حرام”، الذي يشكل تهديدًا إقليميًّا دوليًّا خاصًة في ظل وجود الحدود المُشتركة بين ليبيا ودول الساحل الإفريقي، وجماعة “المرابطون”، ومجلس شورى الدفاع، وتنظيم “أنصار الشريعة”، وتنظيم “القاعدة” في بلاد المغرب العربي، وغيرها من التنظيمات في ظل انهيار نظام “القذافي”، وانتشار حالة من الفوضى على مدى أوسع في الصحراء الكبرى وتحديدًا في الأجزاء الشمالية (تشاد، ومالي، والنيجر، وموريتانيا، وجنوب ليبيا) التي يتحرك فيها الطوارق.
وعليه، أكدّ “الحفني” على ضرورة استمرار الدور المصري على المستوي البحثي تجاه هذه الأوضاع من خلال دراسات المُستقبل في إطار السعي لتوقع الأزمات، وتوجيه المنظمات القارية والإقليمية ودون الإقليمية، ودعم منظومة الإنذار المُبكر.
3- ارتباطات الداخل والخارج بين ليبيا والساحل الإفريقي:
ألمح الدكتور “خالد حنفي”، إلى أنه لا يمكن فهم طبيعة هذا الارتباط دون فهم الارتباط الخرائطي والامتداد الجغرافي بين ليبيا ومنطقة الساحل، وذلك على مستوى العوامل الداخلية والخارجية، والتي أدت إلى مجموعة من التأثيرات، على النحو التالي:
أ- ماهية الارتباط:
– الاكتشاف المتبادل على المستوى المجتمعي، وعلى مستوى الدولة؛ فحينما لا تستطيع الدولة القيام بوظائفها، يدفع ذلك المجتمع باتجاه الانقسام.
– وجود الكثير من نقاط الاشتعال، طيلة الوقت، بسبب الاحتقانات والأزمات الموجودة (خاصة وأن المجتمعات الشابة لها متطلبات وتفرض مزيدًا من التحديات).
– الاختراق ما بين الطرفين، بمعنى آخر، الاختراق بين سياسات القوى الخارجية إزاء المنطقة؛ إذ إن من يريد السيطرة على الساحل يمكنه السيطرة على ليبيا، والعكس.
ب- أبعاد هذا الارتباط:
وفيما يتعلق بأبعاد هذا الارتباط، أشار “حنفي” لمجموعة من التأثيرات والتداعيات المختلفة، والتي تشمل:
– الارتباط الجيوسياسي العام، مع الامتداد القبلي، وبالتالي هناك معضلة في تعريف الساحل الإفريقي، الذي يضم أجزاء من الوسط والشرق والغرب، وإذا أضفنا الشمال، تظهر منطقة الصحراء الكبرى، ما يجعل هناك تصورات مختلفة لحل معضلة الساحل. وفيما يتعلق بليبيا، يعد الجنوب تحديدًا من أكثر المناطق المرتبطة بالساحل، وخاصة مع تشاد.
– سياقات متقاربة للفشل: (فشل تداول السلطة، ضعف الجيوش، تعثر تنموي، هيمنة شبكة زبائنية، تهميش اجتماعي).
– تنامي الجامعات الإرهابية العابرة للحدود: إذ أدى سقوط “القذافي” إلى تلاقي الطوارق مع الجماعات الإثنية، ومع التنظيمات الإرهابية، والتي أدى تزايدها إلى سقوط مالي في 2013.
– ترابط مسارات الهجرة غير الشرعية عبر ليبيا: إذ ينطلق المسار الأول من السنغال، مرورًا بكوت ديفوار ومالي، ثم النيجر، وصولًا إلى ليبيا. لينطلق المسار الثاني من الصومال، شرق إفريقيا، متجهًا أيضًا باتجاه ليبيا.
– صراعات وتدخلات إقليمية: انقسام المعارضة المسلحة في الساحل، والجماعات الإرهابية، تجاه الأزمة الليبية، وانقسام التحالفات البينية.
– ترابط الارتباط الخارجي: إذ إن الفواعل المتواجدة في ليبيا لديها تواجد ومصالح في الساحل، ما جعل هناك ارتباطًا بين الجانبين. وذلك على غرار: فرنسا، روسيا، تركيا، الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي.
ج- التأثيرات المتبادلة لهذه الأبعاد:
- عدوى عدم الاستقرار.
- تراجع الدور الفرنسي في المنطقتين.
- تصاعد مطامع تركيا وقطر في شمال تشاد.
- تراجع التوجه الأمريكي للانسحاب من الساحل.
- تصاعد الدور الروسي لربط النفوذ في ليبيا بالساحل.
- تصاعد وتيرة التهديدات الأمنية (الإرهاب – والجريمة المنظمة)، لأن مسببات الأزمة، والمرتبطة بالأبعاد الاجتماعية والثقافية، لا تزال قائمة.
مُستقبل الدور الإقليمي المصري في منطقة الساحل
طرحت الدكتورة “مروى ممدوح سالم”، مجموعة من المحددات التي ترتبط بملامح وطبيعة الدور المصري، ومن ثم الأهداف والمصالح المصرية في المنطقة، وقد نوّهت -بداية- إلى تراجع الدور المصري في القارة بشكل عام وفي الساحل والصحراء بشكل خاص، منذ خمسة عقود. فمنذ 1967، ساعدت مصر على الحيلولة دون انفصال إقليم جيافرا في نيجيريا، ليتراجع الدور المصري بعدها خمسة عقود، ليقوم الرئيس السيسي بجولة لغرب إفريقيا، بعد تولي مصر رئاستها للاتحاد الإفريقي، والتي يمكن اعتبارها بداية العودة المصرية للقارة، والتي في حاجة للبناء عليها.
فبعد أن كانت المنطقة في مرتبة متدنية في أولويات الأمن القومي المصري، أصبحت الآن حاضرة وبعمق، ليفرض على صانع القرار المصري، أن يكون الساحل الإفريقي ضمن أولويات السياسة الخارجية المصرية، خاصة بعد أن أصبحت ليبيا ساحة مشتعلة، لولوج التنظيمات الإرهابية، المنتشرة في الساحل والممتدة إلى ليبيا. وقد دفعت عوامل التهديد بأن يصبح هذا الملف محل اهتمام مصر، خاصة مع تشابك التدخلات الأجنبية في المنطقة، مما ينتقص من مساحة الدور الذي يمكن أن تلعبه مصر في هذا الصدد. إذ إن تدخلات القوى الدولية، بما فيها القوى الإقليمية، تُقلل من فرص مصر في لعب هذا الدور. هذا فضلًا عن انتشار الفساد، وتأثيره على دعم التكامل الاقتصادي.
وفيما يتعلق بمحدِّدات الدور المصري، حددت “سالم” مجموعة من الثوابت على النحو التالي:
– ضرورة دعم الاستقرار الأمني لدول المنطقة لوقف التمدد القادم من الجنوب الغربي.
– دعم الدولة في غرب إفريقيا، التي تعاني من مساحات خالية ومهددة بالانقسام، ما يدفع بضرورة التصدي لانهيار الدولة.
– احتواء ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
– عدم ترك الساحة خالية أمام الدول التي لديها أجندات متعارضة مع المصالح المصرية.
– تعزيز التعاون الاقتصادي مع منطقة واعدة وجاذبة استثماريًّا، مثل الساحل والغرب الإفريقي، لما يتمتع به من ثروات، هي سبب نكبته.
– التعاون الزراعي، على النحو الذي يحقق الأمن الغذائي لمنطقة تتمتع بالأراضي الزراعية الخصبة.
– دعم التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.
– الاستثمار للترويج لموقف مصر، خاصة موقفها من إصلاح الأمم المتحدة وتوسيع عضوية مجلس الأمن، وذلك عن طريق تأمين كتلة تصويتية إفريقية داعمة للموقف المصري.